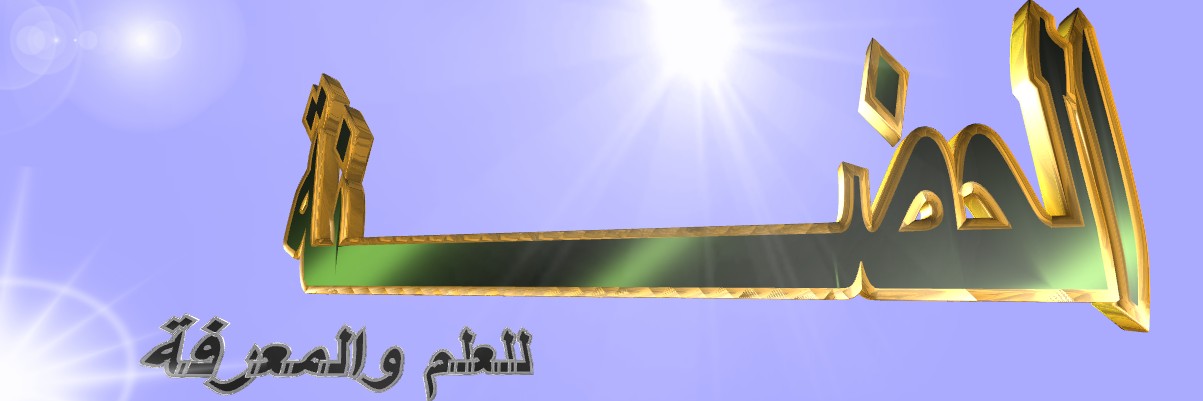تتصدى الدكتورة رزان محمود إبراهيم في كتابها: "خطاب النهضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة" لموضوع واسع إشكالي، بل لعلّه أكثر الموضوعات التي واجهت المثقف العربي على مدى قرنين من الزمن تقريباً إشكالاً، وهو سؤال النهضة والتقدم الذي انفجر جراء الاصطدام العنيف بين العرب والغرب إثر حملة نابليون على مصر عام (1797). وإذا كانت هذه الحملة ما زالت مدار نقاش بين من يعتبرها بداية النهضة العربية الحديثة، ومن يرى أنه قد بولغ كثيراً في أثرها، فمما لا شك فيه أنها قد وضعت الشرق العربي الإسلامي – للمرة الأولى ربّما – في مواجهة حضارة غالبة متفوقة، وجعلت العرب يدركون المسافة الحضارية –وخاصة من النواحي العسكرية والعلمية والمعاشية– التي تفصل بينهم وبين هؤلاء " الغزاة ". ومن حسن الحظ أنّ هذه الانطباعات قد سجّلها شاهد عاصر الأحداث ورآها بعيون يقظة ذكية، هو "عبد الرحمن الجبرتي" الذي أرخ للحملة من وجهة نظر عربية مصرية، ولاحظ أن عناصر الحضارة يؤدي غالباً بعضها إلى بعض، فالتقدم في وسائل العلم والعمران يوازيه تقدم آخر في المعاملة والسلوك، فقد لاحظ أن "الفرنسيس" يستعينون على العمل الشاق بالآلات الكبيرة النافعة، ولا يجبرون الناس على العمل بالسخرة مثلما كان يفعل المماليك، بل يصرفونهم قبل الوقت ويؤدون إليهـم أجورهـم كاملة، ويعاملونهم بالحسنى، وكأنّ ذلك هو الاستثناء، أما القاعدة فهي التسخير والقسوة والاضطهاد.. إلخ.
لقد بات يتردد في كتابات المثقفين الذين ظهروا في القرن التاسع عشر أمثال الطهطاوي والشدياق والبستاني وسواهم مفردات جديدة مثل التمدن، والترقي، والتقدم، وهي ليست جديدة في الاستعمال اللغوي العربي، وإنما تكمن جدّتها في سياقها التاريخي الحضاري، وفي اتجاهها جميعاً لتصب في لفظة واحدة جامعة سادت فيما بعد هي مفردة "النهضة" بما تعني من قيام من الكبوة والوهدة والتأخر واللحاق بركب الحضارة، وتجسير الهوّة بين العرب والغرب في نواحي العمران والصناعة والعلم والسياسة وحقوق الإنسان.. إلخ. ولعل الطهطاوي والشدياق كانا أكثر مثقفي القرن التاسع عشر انشغالاً بالنهضة والترقي، خاصة أنهما عايشا الحضارة الغربية مباشرة، وأتقنـا لغات أوروبيـة قرأوا من خلالها، وترجموا ما رأوا أنه نافع في ترقي أمتهم وتقدمها، وكان تكوينهما التراثي المكين حصنا حال دون الانبهار الأعمى بالغرب وتقدمه، ولكن ما امتازا به من عقل متفتح، وآفاق واسعة جعلتهما يدركان ما يفصل بيننا وبين الغرب من هوّة، ولذلك انشغلا طوال حياتهما في محاولة الإسهام بالنهضة، ولعل ترجمة الطهطاوي للميثاق الفرنسي الذي سمّاه " الشّرطة" أن تكون من أهم المحاولات لإدخال مفهوم الليبرالية الغربية ومبدأ تعدد السلطات، وتفويض السلطة من الشعب للحاكم بناء على ميثاق أو دستور ملزم، وهكذا عرف العرب – للمرة الأولى حسب لويس - عوض مفهوم الليبرالية أو الحرية السياسية، في حين كان مصطلح الحرية في الثقافة العربية والإسلامية له مدلول حقوقي في مقابل العبودية، أما الطهطاوي فقد رأى أن تقدم الفرنسيين في النواحي السياسية يعود أساساً لما سمّاه هو "مبدأ الحريين" الذي حاول شرحه في "تخليص الإبريز" وفي ترجمتـه للميثاق الفرنسي.
والدكتورة رزان تضع يدها منذ البداية على أبرز إشكالات النهضة العربية المعاصرة: وهي الرغبة في الاستقلال والانسجام الذاتي من جهة، والرغبة في التكيف مع المفاهيم الجديدة من جهة أخرى. وهذا لبّ المشكلـة فمشروع النهضة العربي – حسب وجهة نظرها - لم يستطع أن يتبنى قيما فكرية كبرى، وإنّما كانت قيمة تابعة بمعنى ما، وتتجاور في داخلها وخارجها قيم الغرب المختلفة، في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات فكرية تدعو لتحديد مشروع حضاري يهدف إلى الإجابة عن إشكاليات المدينة الفاضلة من خلال رؤية عربية تحاول الجمع بين الخصوصية الأصلية، وبين الانفتاح على العالم؛ فالنهضة عموماً حركة دينامية تاريخية تشكل صراعاً لما كان راداً وتفتيحاً للأذهان المنغلقة في سجون ضيقة. (ص 20)
إنّ هذا الهاجس الذي بدأ في القرن التاسع عشر استمر في القرن العشرين أيضاً بعد أن اتخذ أشكالاً أكثر تركيباً وتعقيداً في تفاعله مع كثير من المفاصل والحوادث التاريخية والحضارية الهامة، فقد حضر الغرب بجيوشه وأدواته الإدارية والمعرفية، وأخضع أغلب الأقطار العربية لسلطته المباشرة، وزرع دولة إسرائيل في قلب العالم العربي بما مثلته من تحد مباشر وشعور دائم بالنقص والغبن، وازدادت تبعية العالم العربي علمياً وعسكرياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً للغرب، وخاصة بعد بروز الولايات المتحدة باعتبارها الوريث الأكبر والأقوى للتحدي والسيطرة الغربيتين. ولن نخالف الحقيقة إذا قلنا أن أغلب المفكرين والمثقفين في القرن العشرين منذ نجيب عازوري، وطه حسين، وأحمد لطفي السيد وصولاً إلى أسماء مثل محمود أمين العالم، وزكي نجيب محمود، وحسين حنفي، ونصر حامد أبو زيد، وحسين مروة، وعبد الله العروي، والطيب تيزيني، ومحمد جابر الأنصاري، وفهمي جدعان، ومحمـد عابد الجابري ومسعود ضاهر وغيرهم كثير.. قد انصبّ جلّ نشاطهم الفكري على مسألة النهضة في تشعباتها المتعددة وتجلياتهـا المركبّة. وليس هؤلاء فحسب، فقد كان الأدب العربي الحديث الذي يعتبر أحد أبرز تجليّات النهضة الحديثة منهمكاً منذ بداياته الأولى في سؤال النهضة على صعيد الأشكال والمضامين، وقد تجلّى ذلك في الشعر بشكل أساسي، ولكن أيضاً في ظهور أنواع جديدة من فنون القول كالمسرحية والقصة القصيرة والرواية كانت ثمرة من ثمار هذا الالتقاء بالغرب، حاولت بدورها الإسهام في تقديم الاقتراحات والرؤى الهادفة إلى النهوض والتقدم. بل لعلّ الرواية – بما هي شكل أوروبي في تطوره الحديث، وليس امتداداً تاماً لأشكال الحكي العربية التراثية، أن تكون في شكلها " الأوروبي " هذا، ثم في طروحاتها الحياتية – منذ بداياتها الأولى في منتصف القرن التاسع عشر من أبرز نواقل أفكار التنوير والتقدم والتحرر الاجتماعي السياسي، والتصدي لقيم الإقطاع، وإعلاء قيم العقل مقابل الخرافة والجهل.. إلخ
فالرواية باعتبارها أكثر الأشكال الأدبية الحديثة "تعقيـداً وانعـدام شكل" كما عبر كايسر تتيح للمبدع أن يقف من الحياة موقف المؤرخ، والمفكر، والسياسي، وعالـم الاجتماع، وعالم النفس، والثائر، والمصلح الاجتماعي.. إلخ؛ لأنها واحدة من الأشكال الأدبية الكبرى التي تعتبر الوريث البرجوازي للملحمة القديمة بما يمكن تضمينها من عناصر ورؤى وأفكار تتوجه للفرد الذي يقرؤها على حدة، ثم لأبناء اللغة الواحدة، مقدمة لهم من خلال التخييل والتشويق عالماً يوحي بالواقع ويطرح أسئلـة الحياة نفسها، ويعايش أبطالها مصائر البشر العاديين، ولذلك لم يتردد الفلاسفة والمفكرون في أن يقدموا رؤاهم الفلسفية والفكرية من خلال روايات، مثلما فعل غوته وسارتر وسواهما.
ومن هنا تأتي أهمية كتاب الدكتورة رزان محمود إبراهيم، هذا في إبرازها لهذا الموضوع الإشكالي الهام المتمثل في قراءة أسئلة النهضة العربية ومحاولات معالجتها وتقديم الاقتراحات لها من خلال الإنتاج الروائي العربي المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية، وهي الفترة التي شهدت احتدام حركات الاستقلال من الاستعمار الغربي، وضياع فلسطين واحتدام الأيدويولوجيات، التي عبرت عن نفسها من خلال الأحزاب والانقلابات العسكرية والأحلاف السياسية، ثم معايشة هزيمة حزيران (1967)، وازدياد المواجهة مع الغرب مواربة وتعقيداً.. إلخ. ويتصدى كتاب الدكتورة رزان إبراهيم هذا لهـذا الموضوع الإشكالي الهام الذي يزداد راهنية وإلحاحاً مع الوقت بنظرة شمولية واسعة اشتملت علـى أبرز قضايا النهضة والتقدم وإشكالاتها المتعددة المركبة، محاولة تلمّس هذه القضايا في الرواية العربية المعاصرة من خلال عدد من الأسئلة الكبيرة وتفرعاتها التي تشكل مجتمعة – حسب رؤيتها – خطاب النهضة والتقدم المعاصر منذ الحرب العالمية الثانية حتى وقتنا الراهن، وهذه الأسئلة هي:
- خطاب التحرر والاستقلال.
- الخطاب القومي الوطني.
- أسئلة الخطاب الليبرالي.
- أسئلة الخطاب الاجتماعي.
- خطاب الحداثة.
- أسئلة الهوية والتراث والإسلام.
وتحاول الباحثة معالجة هذه الأسئلة توظيف المنهج الثقافي (Cultural Model ) في تحليل النص الروائي بهدف استقراء خطاب النهضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة، باعتبار أن النص الروائي شكل ثقافي يتمظهر بأساليب وبنى ولغة فنية خاصة. وترى أن هذا المنهج ربّما يكون أكثر المناهج ملاءمة لدراسة الرواية العربية ضمن عنوان هذه الدراسة وأسئلتها المتفرعة عنه؛ فالرواية هي – في نهاية المطاف – خطاب يتأسس على العلاقة التفاعلية بين مصدر الخطاب والمخاطب (بفتح الطاء)، والسيـاق الثقافي الاجتماعي المحيط، والوسيط اللغوي الناقل. وهذا الخطاب هو نتاج تفاعل وعي الكاتب ومرجعياته الفكرية مع أسئلة الواقع وحركة الحياة (ص 9). والكاتبة على وعي باختلاف الخطاب الأدبي الذي تمثله الرواية عن الكتابات الفكرية النظرية المباشرة، فالخطاب الروائي يخضع لشروط الأساليب الفنية التي تميّزه عن غيره من الأنواع، إلى جانب ما يبتدعه الكاتب من أشكال وأساليب فنية خاصة، وهي في أثناء تحليلها للخطاب من خلال تجلياته في الوسيط الفني الروائي لا تبحث فقط فيما تقوله الأساليب الفنية، بل كذلك عمّا يختفي وراء هذه الأساليب من الغائب والمسكوت عنه.
أما مفهومها للنقد الثقافي الذي تتوسله منهجاً للنظر في نصوصها الروائية المختارة، فإنه يتأسس بشكل عام على طروحات (عبدالله الغذامي) في كتابه: "في النقد الثقافي" الذي يتلخص مفهومه للنقد الثقافي، في أنه تغيّر في منهج التحليل من خلال استخدامه للمعطيات النظرية السوسيولوجيا والتاريخ والسياسة، من دون أن يتخلى عن مناهج التحليل الأدبي، فهو ينفتح على ما هو غير جمالي، ولا يؤطر فعله تحت إطار تصنيفات النص الجمالي، ويستفيد من مناهج التحليل المعرفية من مثل تأويل النصوص، ودراسة الخلفية التاريخية، إضافة إلى إفادته من الموقف الثقافي النقدي والتحليلي المؤسساتي، وبالتالي فإن النقد الثقافي ينهج تحليلاً وظيفياً يفسّر النصوص من دون أن يعزلها عن تفاعلاتها الواقعية والبشرية والثقافية، ففي الوقت الذي ينظر فيه إلى النصوص التي يتناولها باعتبارها أعمالاً أدبية جمالية، فإنه ينظر إليها أيضاً باعتبارها حوادث ثقافية تلعب القيم الجمالية فيها أدواراً خطيرة من حيث هي أقنعة تختبئ وراءها أنساق معينة، وتتوسل بها لعملها الذي ينتظر من هذا النقد أن يكشفه (ص12).
وهذا المنهج في استيعابه لعناصر الخطاب من رسالة وسياق اجتماعي وثقافي وعلاقة منتج الخطاب مع متلقيه، ينجو بذلك من مثالب المناهج الاجتماعية الأيديولوجية التي سادت في الستينات، وكانت تهمل العناصر الفنية لحساب قراءة المضامين الفكرية والاجتماعية، حتى كانت النصوص الأدبية تبدو كأنها مجرد وثائق فكرية لا تختلف عن أنماط الكتابة غير الجمالية، مثلما ينجو هذا المنهج (الثقافي) في الوقت نفسه من مثالب المناهج البنيوية التي عزلت الأعمال الأدبية عن سياقاتها وإحالاتها الخارجية، واختزلتها في بنى وأنساق لغوية داخلية لا تحيل إلاّ على ذاتها، كما أن الباحثة تستند في مفهومها للمنهج الثقافي إلى تنظيرات (ميشيل فوكو) عن تحليل الخطاب، الذي يرى أن الخطاب شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تبرز فيها الكيفية التي ينتج يها الكلام بصفته خطاباً ينطوي على الهيمنة والمخاطر في الوقت نفسه، فللخطاب دور واع يتمثل في الهيمنة التي يمارسها أصحاب حقل معرفي أو مهني على صحة خطاب المتحدث ومشروعيته، مما يشير إلى أن أنتاج الخطاب ليس حراً، وإنّما يخضع إلى مجموعة من المعايير الاجتماعية والثقافية السائدة. (ص 18).
ولكن العقبات المنهجية التي يمكن أن تواجه مثل هذا النوع من الأبحاث كثيرة، ليس أقلّها اتخاذ معيار موضوعي لاختيار النماذج الروائية ودراستها في ضوء تلك الأسئلة التي طرحتها الدراسة، وتظل المعايير التي وضعتها الباحثة (ص 14) في تسويغها لترجيح اختيارتها – على وجاهتها – فضفاضة وقابلة للتأويل على وجوه متعددة، فاحتواء العمل (الروائي) على رابط منطقي وتماسكه الداخلي النسبي المقبول – حسب تعبيرها – شرط يجب أن يتحقق في أي عمل ناجح سواء كان روائياً أو نظرياً. أما معيارها الثاني – وهو " احتواء العمل (الروائي) على بعد نهضوي واضح يجعله قادراً على عكس رؤية نهضوية تقدمية ملموسة تهيئ للدراسة استخلاص إجابة ما عن مجموعة الأسئلة المطروحة فـي هذا البحث "فإنه كذلك لا يجنّب البحث من شرك الوقوع في اختيار أعمال ترفع شعارات النهضة عاليـاً على حساب شروط الفن الروائي، مما يجعل المقولات الواضحة هي الجاذب لاختيار هذا النموذج واستبعاد ذاك. وهذا ما وقع فيه البحث عند اختيار عمل– قد يكون شديد الدلالة على السؤال المطروح للمناقشة، ولكنّه يطرح أسئلة أشدّ تعقيداً عن قيمته الفنية أساساً، والمقصود هنا رواية يوسف السباعي "جفت الدموع". أما تحرز الباحثة عن ذلك بأن يكون العمل قد نال ولو درجة بسيطة من اهتمام النقاد وهو معيارها الثالث، فإنـه معيار يخرج عن النظر الموضوعي؛ لأن أعمالاً تافهة قد تنال من الاهتمام – لأسباب مختلفة – أكثر مما يستحق العمل نفسه، أو أكثر من أعمال ربّما تكون أكثر أهمية، ويجري إهمالها نقدياً لسبب أو لآخر.
وقد يكون من مزالق هذا المنهج أن تتساوى لديه الأعمال الروائية الرديئة والأعمال المتفوقة، فالعمل الروائي التافه يحمل أيضاً خطاباته الخاصة المتعددة التي يمكن تأويلها في ضوء المنهج الثقافي، بل ربّما يكون هذا المنهج أكثر المناهج المعاصرة اهتماماً بالإنتاج الثقافي الهامشي؛ لأن هذه الأعمال التافهة قد تحمل أحياناً دلالات ومؤشرات قوية على الأسئلة المطروحة، أكثر من كثير من الأعمال المتفوقة التي تذوب فيها الأيديولوجيا والرؤى الحياتية في بقية العناصر الفنية واللغوية.
أضف إلى ذلك المساحة الزمنية الجغرافية الواسعة التي تتخذها الدراسة ميداناً لنظرها، والشعور بضرورة اختيار أعمال ممثلة للأقطار العربية من الخليج حتى الأطلسي مثلما أشارت الباحثة في مقدمتها (ص 3)، وهو في نظري أحد المزالق الخطيرة التي تختلط فيها المعايير؛ لأن الأدب ينتمي إلى اللغة التي يكتب بها بالدرجـة الأولى، ولذلك فقد يكون روائي من هذا القطر – علـى سبيل المثال – أكثر حضوراً في قطر آخر من أغلب كتاب هذا القطر الآخر أنفسهم. وينضاف إلى هذا المأخذ أيضاً إخضاع روايتين للكاتب الفرنسي من أصل لبناني وهو أمين معلوف لأسئلة الدراسة، ممّا يعيد طرح التساؤل عن معايير الاختبار مرّة ثانية. فـ"ليون الإفريقي" و "القرن الأول بعد بياترس" هما روايتان فرنسيتان من حيث اللغة، وفي أحسن الأحوال روايتان فرانكفونيتان، وإذا كان من المسوّغ لاتخاذهما ميداناً للدراسة ضمن أسئلة البحث المطروحة فمن المشروع إذن التساؤل عن غياب روايات لكتّاب مثل "كاتب ياسين" و"مالك حداد" و"محمد ديب"، وسواهم كانوا أكثر التصاقاً بواقع الأقطار العربية وقضايا مواجهة الاستعمار الغربي، والعلاقة بالآخر؟
هذا إلى جانب أنّ هذه المساحة الواسعة بشقيها الزماني والمكاني التي أدت بالباحثة إلى قراءة اثنين وعشرين عملاً روائياً بشكل رئيسي، إلى جانب عشرات الروايات الأخرى التي جرى تناولها تناولاً سريعـاً للوقوف علـى رؤى ومقولات موازية أو مناقضة – تجعـل أسئلتها - المطروحة تتجلى بشكل أكثر سطوعاً – كل ذلك قاد في بعض الأحيان إلى أن يجيء تناول هذه الروايات مركزاً على المقولات البارزة التي تشتبك مع الأسئلة الهامة المطروحة أو تؤشر عليها، مما حجب عن القارئ الذي لم يسبق له قراءتها كاملة – رؤاها الكلية وحضورها الذهني والوجداني الذي يسعى الفن الروائي إلى خلقه باعتباره تخييلاً يصنع فـي اللغة عوالم موازية للحياة، ومع ذلك فقد استطاعت الباحثة تجاوز أغلب هذه المحاذير، وظلّت مخلصة عموماً لمنهجها الثقافي من خلال النظر في سياقات ثقافية وفكرية واجتماعية موازية ومحايثة للروايات المدروسة، مثلما فعلت عند قراءة "دفنّا الماضي" للمغربي (عبد الكريم غلاب) في ضوء سؤال المواجهة مـع الاستعمـار، واستخلاص رؤيتها في الموقف المزدوج من الآخر المتسعمر (بكسر الميم الثانية ) وتتبع طروحات الكاتب النظرية المتعلقة بأسئلة الاستقلال والحرية، ومفهوم الذات والآخر في كتابه: " تاريخ الحركة الوطنية من نهاية الحرب الريفية إلى إعلان الاستقلال" (1976). وهذا ما فعلته أيضاً في مواقع أخرى من عملها في البحث عن التوازي والتعارض بين رؤى الكتاب في أعمالهم الروائية، ثم في أعمالهم النظرية والفكرية الأخرى، وخاصة لدى كتاب أمثال عبـد الله العـروي، وعبـد الرحمن منيف، وحليم بركات.. إلخ.
وقد تكون الأعمال التي تعرضت لهذا الموضوع أو ذاك من قضايا النهضة والتقدم، مثل المواجهة مع الآخر، وموضوعة المرآة، والقضايا القومية، أو قضية فلسطين.. إلخ كثيرة، ولكن هذا الكتاب قد يكون أول من حاول قراءة المنتج الروائي العربي المعاصر عبر نماذج مختارة منه ضمن هذا الأفق الشمولي لسؤال النهضة والتقدم، وتشتمل الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا العمل على أكثر أسئلة الواقع العربي المعاصر راهنية وإلحاحاً، إذْ تناقش هذه الفصول قضايا مثل مسألة العولمة، والكتابة النسوية وتحوّلات صورة المرأة في الرواية العربية وخاصة عبر مفاصل هامة مثل هزيمة حزيران، وأسئلة الحداثة العربية من خلال مناقشة مفهوم الحداثة، والبحث عن مظاهراها المتنوعة في الحياة العربية، والفصل السابع الأخير الذي عقد لمناقشة قضايا هامة مثل مسألة الهوية، والتراث، والعولمة، والموقف من الإسلام، وإشكالية الخصوصية الحضارية، وربّما يؤخذ على هذا الفصل بالذات ما سبق الإشارة إليه، وهو دراسة مسألة الهوية من خلال روايتين لأمين معلوف مكتوبتين باللغـة الفرنسية، لأنّ اللغة في نهاية الأمر هي خطاب بحد ذاتها، أي محمول ثقافي اجتماعي حضاري يعدّ من أبرز مكوّنات الهوية الحضارية والخصوصية الثقافية، ولا يكفي في مثل هذه الحال أن تكون بيئة هذين العملين الروائيين بيئة عربية أو إسلامية في مكوناتها، فأحد شقيّ الخطاب وهو المتلقي هنا ليس عربياً وإنّما أوروبي فرنسي بحكم الناقل اللغوي المستخدم، وهذا يخرج بهذين العملين في رأيي من المصنف الروائي العربي ويدخلهما في المصنف الروائي الفرنسي، وعليه فإن أمين معلوف ليس كاتباً عربياً، وقد لا يعتبره الفرنسيون كاتباً فرنسياً أيضاً وإنّما كاتب فرانكوفوني، أو ممثل لأدب الأقليات المكتوب بالفرنسية في أفضل الأحوال.
وعلى أية حال، فقد استطاعت الكاتبة –بشكل عام– قراءة الأسئلة المتفرعة عن عنوان كتابها في الروايات العربية من خلال المنهج الثقافي قراءة ذكية تستنطق المعلن والمسكوت عنه في الوقت نفسه، فلاحظت في بعض الروايات ذلك الحضور الواضح للخطاب الذي يربط لحظات الوعي والنهضة والتقدم بالانفتاح الشمولي على الغرب ما يحمل شعارات الحداثة والحقوق المدنية والسياسية، وهو الخطاب الذي يسكت أحياناً عن الصورة الأخرى للغرب أي الصورة الاستعمارية التسلطية. فعبد الكريم غلاب على –سبيل المثال– في روايته "دفنّا الماضي" يبرز شخصية المعلم الفرنسي في جوانبها الإيجابية التنويرية، ويتغاضى عن الوجه الآخر للصورة، وهي تسخير ثقافته وعلمه لخدمة الإدارة الاستعمارية، وتساءلت الكاتبة أيضاً عن اختيار بطل "شرق المتوسط" لعبد الرحمن منيف لبلد أوروبي غربي للإقامة فيه بديلاً عن بلاد القمع في شرقي المتوسط. مثلما لاحظت كيف وقع حليم بركات في تناقض ملحوظ حين اتهم الشعب بازدواجية الشخصية، ووقع هو نفسه في ذلك وهو يقوم بعملية تقويم الذات العربية، وذلك في أثناء مناقشتها لروايته "عودة الطائر إلى البحر" (انظر بشكل خاص ص59).
أما فيما يتعلق بالفكرة القومية فقد لاحظت الكاتبة أن الرواية العربية قد أبرزت هذه الفكرة بوصفها معلماً من معالم المسيرة النهضوية عبّر عنها الروائيون بشكل متفاوت، ويتمثل ذلك في رواية "جفت الدموع" ليوسف السباعي التي نزعت نزعة طوباوية في تمثيل فكرة القومية، أدّت إلى تسويغ شرعية البطل الأوحد، وقدمت الوحدة على أنها فكرة سامية تجيز إلغاء الحوار والتطور الديمقراطي في سبيل إنجازها. وهذا على عكس رواية "قالت ضحى" لبهاء طاهر التـي رأت في الوحدة أمراً تاريخياً يتشكل من خلال عمليات اجتماعية بطيئة ومعقدة، إذ نظرت الروايـة إلى فكرة القومية نظرة واقعية موضوعية، انعكست في الوقت نفسه على التشكيل الروائي ذاته، وإذا كانت الكاتبـة قـد أظهرت حيـرة فـي اجتلاء صورة "ضحى" في هذه الرواية؛ لأنها وقفت متوارية وراء الكلام المحتد المتقاطع، وكانت شخصيتها جزءاً من الهندسة اللغوية للنص (ص109)، إلاّ أن ضحى تبدو في هذه الرواية رمزاً شمولياً يمثل مصر.
أما سؤال الحرية فقد رأت الكاتبة أن الرواية العربية قد استطاعت رسم صورة حيّة لواقع التعسف والظلم والقمع تفوقت على كثير من الدراسات النظرية، وقد تمثل ذلك في رواية "شرق المتوسط" لعبد الرحمن منيف و"تلك الرائحة" لصنع الله إبراهيم.
وخلصت الدراسة إلى القول فيما يتعلق بالخطاب الاجتماعي أن الرواية العربية كانت أميل إلى الاتجاه الواقعي في تصوير الحياة، وكان محور اهتمام الأعمال الروائية ينصب إلى التمييز بين طور الواقعية النقدية، والواقعية الاشتراكية ضمن جدلية كبرى هدفت إلى التركيز على العيوب ومظاهر الفساد، واتخاذ الأدب وسيلة لكشف المشاكل والقضايا الاجتماعية عن طريق تحليل الواقع وفهمه. وفيما يتعلق بصورة المرأة فقد لاحظت الكاتبة أن المرأة في الواقع كانت أكثر تقدماً من صورتها في الرواية النسوية العربية، بل إن الكاتبات العربيات - على وجه العموم – ابتعدن في كثير من الأحيان عن بلوغ واقع المرأة، وإدراك مشكلاتها النوعية الناجمة عن الظروف المستجدة التي لا بد أن تنعكس على وضع المرأة، وقد لاحظت الدراسة تحولاً نوعياً طرأ على صورة المرأة في الرواية، إذ انتقل التركيز من الإلحاح على موضوع الحرية في البدايات إلى المشاركة التامة للرجل في صنع الواقع بعد هزيمة حزيران 1967، وهما أمران لا ينفصلان على أية حال، وإنما يؤدي أحدهما إلى الآخر بالضرورة.
أما فيما يتعلق بخطاب الحداثة، فقد كان التعبير الفني الذي أنتجته الرواية العربية عن وعي الحداثة يسعى إلى تحطيم أركان التقاليد الفنية الموروثة في سبيل تأسيس خطاب حداثوي يقوم على صورة الحداثة الأوروبية ويتخذها مرجعاً وحيداً، ولكن هذه الصورة أخذت تتعدل لاحقاً لتصبح الحداثة أمراً يتداخل مع كل مشروع يعد بالتقدم وقيم العدل والحرية ورفض التبعية، وانعكس ذلك على صعيد الشكل الروائي في مغامرات تجريبية وأسلوبية جديدة تسعى إلى التطور باستمرار، ولذلك باتت الأشكال الروائية أكثر تعقيداً في خضم تعبيرها عن واقع مركب متداخل.
وقد لاحظت الكاتبة أن الروائي العربي عموماً تجاهل وجود خطاب إسلامي معارض، واكتفى بالتركيز على خطاب إسلامي تحتويه الأنظمة، ولذلك قدمت الرواية العربية صورة نمطية للشخصيات الدينية بصفتها نماذج متطرفة متواطئة منتفعة لا تكسب تعاطف القارئ. وغالباً ما طرحت الرواية العربية العقل الديني بوصفه عاملاً رجعياً يعيق التقدم. مثلما يتجلّي ذلك في روايتي "حكاية زهرة"، و"وردة الصحراء" لحنان الشيخ اللتين تقدمان صورة سلبية منفرّة للشخصيات التي تمثل الإسلام أو الدين عموماً. (ص224–225).
أما فيما يتعلق بالعلاقة بالآخر أي الغرب تحديداً في الرواية العربية، فقد خلصت الدراسة إلى أن النظرة إلى الغربي قد تدرجت من الانبهار بالغرب وتقبله إطاراً وحيداً للتقدم الاجتماعي والحضاري كما في رواية "في الطفولة" للطاهر بن جلّون، إلى شكل من أشكال الحيرة والتأرجح بين الشرق والغرب، مثلما بدا ذلك في رواية "المرأة والوردة" لمحمد زفزاف، إلى أن يصبح الغرب نفسه موضوع تأمل وانتقاد كما في رواية "الغربة" لعبد الله العروي، حيث ينتهي الأمر إلى أن يصبح الغرب خصماً مثلما تجلى ذلك في رواية "اليتيم" لعبد الله العروي أيضاً (ص227–230) علماً بأن الروائي العربي قد استعار هذا النوع الأدبي من الغرب، وعليه فإن الغرب حاضر ضمناً في الرواية العربية، بوصفه قيماً تعبيرية وأيديولوجية وفكرية، وإن حاول بعض الروائيين العرب أمثال إميل حبيبي، وجمال الغيطاني بشكل خاص، تطويع بنية بعض أشكال الموروث السردي العربي الكلاسيكي لاستيعاب رؤاهم العصرية في أعمالهم الروائية.
************
دار الشروق، 2003، ص271، عمّان.