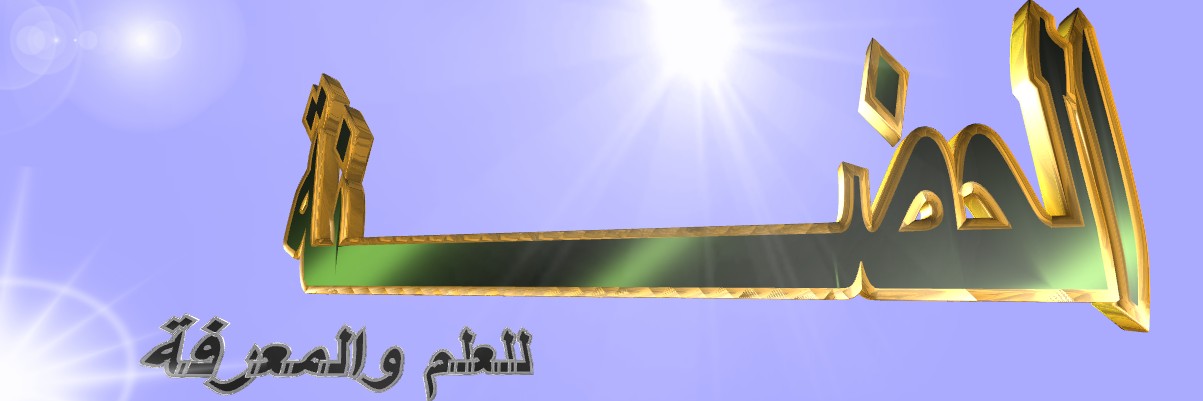يدرس باتريس بافيس في دراسته (الإرسال والتلقي في المسرح) العلاقة الجدلية بين عمليتي الإرسال والتلقي، التي أعادها إلى محور اهتمامه، كما يقول، كل من أمبرتو إيكو، وآن أوبرسفيلد، وماركو دي ماريني، الذين أشاروا إلى تهافت وجهة النظر التي ترى أن الفن عملية ذات اتجاه واحد تحدث بين مُرسِل ومُستقبِل، مؤكداً على أن الإرسال لن يكون فعالاً من دون الأخذ في الاعتبار دور المتلقي، كما أن فعل التلقي لا يمكن استيعابه من دون الرجوع إلى عملية الإرسال(1).
1- نقد السيميائية المبكرة
يأخذ بافيس، في ضوء قناعته بالجدلية بين عمليتي الإرسال و التلقي، على ما يسميها بالممارسات السيميائية المبكرة، التي اعتمدت على أطروحات الشكلانيين الروس (كما تجلت في كتابات منظري حلقة براغ، 1926- 1948) نظرتها إلى العمل الفني بوصفه عملية إرسال مكتملةً ونهائيةً، كما هي نظرة البنيوية، وتجاهلها حقيقةً أساسيةً مؤداها أن نسق الإرسال الدال لا يصوغه فقط مبدعو العمل الأصليين، بل يشارك في صياغته أولئك الذين يتلقونه. ولذلك فإن تلك السيمياء غير قادرة، من وجهة نظره، على تفسير ديناميكية نظم العلامات، والآليات المختلفة التي تحكم نظم الدلالات المختلفة في المسرح(2)، ومن ثم فإنها تؤدي، في النهاية، إلى تسطيح نظم العرض المسرحي، وتجاهل البنية الهرمية الديناميكية بين هذه النظم، فضلاً عن تجاهل المتلقي، وهو الشخص الوحيد القادر على إدراك كل من هذه البنية وعملية إنتاج المعنى وإرساله. ولكن بافيس يناقض نفسه بعد صفحتين حينما يعترف بأن اتجاه حلقة براغ تميز عن اتجاه الشكلانيين الروس بالدعوة إلى انفتاح النص على التاريخ، وسمح بإمكانية اقتراح تصور آخر عن عملية إنتاج الدوال ومدلولاتها في العمل الفني، فارتكز هذا التصور على الربط بين التلقي والتغييرات التي تحدث في السياق الاجتماعي، وأن هذا الانفتاح، الذي ميز حلقة براغ، جدير بأن يصبح أحد الروابط الأساسية التي تعقد الصلة بين الإرسال والتلقي(3). ويذهب بافيس أبعد من ذلك فيقرّ بأن هذا الانفتاح الذي ميز حلقة براغ هو أحد المنطلقات التي يرتكز عليها نموذجه الذي يقدمه في دراسته هذه. وفي حقيقة الأمر أن بافيس يتجنى على سيمياء حلقة براغ حين يصفها بأنها غير قادرة على تفسير ديناميكية العلامات في المسرح، وأنها تؤدي إلى تسطيح نظم العرض، وتتجاهل المتلقي. وسنحاول إثبات هذا التجني من خلال مراجعة التنظيرات التي قدمها بعض أعضاء هذه الحلقة، ونبدأها بمقال بيتر بوغاتيرف ( السيمياء في المسرح الشعبي)، فهو يؤكد فيه على أن كل شيء في المسرح يغير إشارته بسرعة شديدة، وبتنوع كبير، فـ "الأشياء التي تلعب دور الإشارات المسرحية على الخشبة يمكن في سياق المسرحية أن تكتسب ميزات، وخصائص، وصفات معينةً لا تتمتع بها في الحياة الواقعية. إن الأشياء في المسرح، تماماً مثل الممثل نفسه، قابلة للتحول، كما يمكن أن يتحول الممثل، على الخشبة، إلى شخص آخر (شاب يتحول إلى شيخ، وامرأة إلى رجل... إلخ)"(4). كذلك الشيء الذي يستعمله الممثل في أداء دوره يمكن أن يعطي مدلولات جديدةً لم تكن من قبل من خصائصه ومميزاته، فالحذاء المتهرئ لشارلي شابلن يتحول، بفضل لعب هذا الأخير، إلى طعام، وخيوط الحذاء إلى معكرونة، وقد تتحول العصا، في مسرحية ما، إلى حصان [في مسرحية رسالة الطير للمخرج العراقي قاسم محمد تشكل العصي علامةً مهيمنةً تتحول من دلالة إلى أخرى باستمرار] ، والدكة إلى عربة، والمقعد إلى قارب(5).
ويشير بوغاتيرف إلى أن مثل هذه الأشياء المتحولة التي يستخدمها الممثل في العرض المسرحي شائعة كثيراً في المسرح الشعبي.
وفي مقاله (ديناميكية الإشارة في المسرح) يرى ييندريك هونزل أن المسرح ليس له وظيفة أخرى سوى الإشارة إلى شيء آخر، ويكف عن أن يكون مسرحاً إذا لم يدل على شيء آخر(6).
ولأن بنية العرض المسرحي تتشكل من مجموعة فنون بصرية وسمعية متداخلة، ومندمجة بعضها ببعض، وليست تركيباً لمجموعة فنون مستقلة أو منفصلة بحيث يُدرَس كل فن على حدا، كما تدعي نظرية فاغنر حول المسرح التركيبي، فإنها ذات خاصية سيميائية تحولية يمكن أن تنتقل فيها الإشارة من مادة إلى أخرى بحرية لا تعرفها الفنون الأخرى(7) خارج الفضاء المسرحي، ويضرب هونزل أمثلةً عديدةً على ذلك، فالإشارات التي يفترض فيها تعيين الفضاء المسرحي الذي يقع فيه الفعل لا يعني أنها يجب أن تكون إشارات فضائيةً (مواد أو عناصر ديكورية ملموسة)، بل يمكن أن تكون أشارات صوتيةً (مثلاً في الفصل الأخير من مسرحية بستان الكرز لتشيخوف، يلعب البستان الدور الأساسي، إنه على الخشبة، و لكن المتلقي لا يشاهده لأنه لم يشر إليه فضائياً، بل عبر عنه صوت ضربات الفؤوس التي تسمع وهي تقطع أشجار الكرز)(

، ويمكن أن تكون إشارات ضوئيةً. ويحتمل أن يكون الممثل إشارةً لعنصر فضائي أيضاً، كما في بعض تجارب المخرج الروسي أوخلوبكوف، فقد ابتدع ممثلاً- بحراً بجعله شاباً يلبس، بطريقة حيادية، (الأزرق، أي مئزراً غير مرئي، ويضع قناعاً أزرق على وجهه)، ويهز بقماشة زرقاء يشوبها الاخضرار ملتصقة بالأرض، بشكل يستعيض تموج القماشة إيحائياً عن أمواج قناة بحرية. كما خلق ممثلاً أثاثاً وذلك بجعله ممثلين اثنين، مرتديين بشكل غير ملحوظ، يركع أحدهما قبالة الآخر وهما يبسطان غطاء طاولة بينهما كمربع يوحي بطاولة. وأوحى أيضاً، في أحد عروضه، إلى حدوث عاصفة ثلجية من خلال ممثلين يرتدون مآزر زرقاء، ويتراشقون بقصاصات ورق صغيرة، وهم يتقافزون محدثين ضجيجاً(9).
ويمضي هونزل في تنظيره لديناميكية الإشارة في المسرح، مؤكداً على أن المرء يستحيل عليه أن يقرر جازماً ما إذا كان عنصر الحركة لن يدل عليه عنصر آخر من عناصر العرض المسرحي، أو أن يتنبأ بأن ما يُعد ظاهرةً لغويةً لن يعهد به إلى ظاهرة تشكيلية، كتحول بعض المقاطع الحوارية إلى صور، أو تحول حركات الممثل إلى رقصة تعبيرية، أو توظيف مشبه للإيحاء إلى الفضاء، كما في المثال الآتي المأخوذ عن المسرح الياباني: "يترك رانسوك القصر المحاصر. يمشي من الخلفية إلى الأمام، فجأة ترتفع الستارة الخلفية في الوراء تصور باباً بحجم طبيعي، ونرى ستارةً أخرى عليها باب أصغر يشير إلى أن الممثل يتقدم من بعيد. يستمر رانسوك في طريقه. ستارة خضراء داكنة تهبط فوق الستارة الخلفية في الوراء مشيرةً إلى أن رانسوك لم يعد يرى القصر. خطوات أخرى قليلة ورانسوك ينطلق على " طريق الأزهار" لكي يدلل على هذه المسافة التي لا تزال كبيرة، يبدأ العزف على السميسين (نوع من الماندولين الياباني) وراء المشهد.
الانسحاب الأول: خطوة في المكان.
الانسحاب الثاني: تغيير في مشهد مرسوم.
الانسحاب الثالث: رمز تقليدي (ستارة) يلغي عنصر الخشبة البصري.
وهذا يفسر تبدل عناصر الخشبة التي تأخذ بالتعاقب الوظيفة ذاتها، على أنه تدرج لفعل درامي واحد: مشي رانسوك، وابتعاده عن القصر"(10).
و بتعابير مجازية يقول هونزل إننا "يصدف أن نرى الأنغام"، و"نسمع الريف المنشرح"(11) إشارةً إلى إمكانية حلول العنصر السمعي محل العنصر البصري للدلالة على الفضاء (كما في المثال السابق عن بستان الكرز)، أو على العكس من ذلك حلول العنصر البصري محل العنصر السمعي للدلالة على الصوت، إذ "لا ضرورة لأن يشار إلى الفضاء بعنصر الفضاء، أو للصوت بعنصر الصوت، أو للضوء بعنصر الضوء، ولا ضرورة للنشاط الإنساني أن يرمز إليه بفعل الممثلين"(12).
ويرى هونزل أن تحول الإشارة المسرحية من مادة إلى أخرى بحرية هو واحدة من الخصائص التي ينفرد بها المسرح، وتميزه عن الفنون الأخرى غير الأدائية، "فلا توجد موسيقى من دون أنغام، ولا قصيدة من دون كلمات، ولا لوحة من دون ألوان، ولا نحت من دون جوهر فيزيائي"(13). ويستثني هونزل بعض الحالات النادرة التي يستعير فيها الفنان عناصر من حقل فني آخر إذا كانت مواد فنه لا تحقق القوة المطلوبة في التعبير.
وفي السياق نفسه يقف يوري فلتروسكي، في مقاله (الإنسان والموضوع في المسرح)،على تحول الممثل إلى قطعة اكسسوار (اكسسوار بشري)، أو إلى جزء من الديكور (ديكور بشري)، ويضرب أمثلةً على ذلك بشخصيات الخدم التي توجد في المسرح بأعداد كبيرة، فهي بدخولها وخروجها صامتةً تبدو للمتلقي كأنها أقرب إلى الاكسسوار منها إلى شخصيات فاعلة (كما في ملهاة " كل يعمل شيئاً لوطنه " لكليبرا، وإخراج إي أف. بوريان، التي تتألف شخصياتها كلها من خدم صامتين)، وكذلك الجنود الذين يحرسون مدخل منزل، فهم يدلون على أن المنزل هو ثكنة، ولا يمكن عدهم، بأي شكل من الأشكال، ممثلين فاعلين لأن إشاراتهم التأسيسية محدودة للغاية، فهي تنحصر في وقفتهم، مرتبتهم، مكياجهم، وثيابهم، ولذلك يمكن استبدالهم بتماثيل. ويطلق فيلتروسكي على فعل مثل هؤلاء الممثلين صفة "الفعل في درجة الصفر" [ربما أخذ بارت عبارة الكتابة في درجة الصفر من عبارة فيلتروسكي هذه]، حيث ينتقلون من مجال الإنسان إلى مجال الشيء(14).
إن خلاصة مابحثه سيميائيو حلقة براغ، فيما يتعلق بقدرة العلامات المسرحية على التحول، أو ديناميكيتها هو أن لهذه العلامات خاصية أساسية تتمثل بـ :
1- تبادل المواد، والانتقال من مظهر إلى آخر.
2- بعث الحياة في الشيء الجامد، أو العكس.
3- التحول من مجال السمع إلى مجال الرؤية، أو العكس(15).
أما فيما يتعلق بالمتلقي، فإن أغلب أعضاء هذه الحلقة قد تطرقوا إليه في حدود متباينة، ولكن من دون تركيز كبير كما فعل بعض الباحثين، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، في أبحاثهم ومقالاتهم المكرسة لجماليات التلقي ونظرياته في المسرح، ففي مقاله (حول الوضع الراهن لنظرية المسرح) يبدأ يان ميوكاروفسكي تنظيراته بالقول "إن كيفية إقامة تواصل فعال بين المتفرج والخشبة هي واحدة من المشكلات التي حاول المسرح المعاصر أن يحلها بطرق مختلفة. والمسرح- بالتأكيد- هو المسؤول الأول عن حل هذه المشكلة"(16). ويكشف هذا القول عن قناعة ميوكاروفسكي بأن المتلقين طرف آخر في المسرح ينبغي حثهم على الفعل، ولا يرى أنهم جماعة محددة من الناس تتردد على المسرح، بل ممثلون لكل اجتماعي، ولذلك انتقلت المشكلة من مشكلة بين المتلقي والمسرح إلى مشكلة العلاقة بين المسرح والمجتمع. ولكن على الرغم من أن المتلقين ليسوا متجانسين اجتماعياً، فإنهم متحدون برابطة الاستجابة لفن المسرح، ورثوا، أو اكتسبوا قدرةً على تبني موقف جمالي تجاه المواد التي يتعامل بها هذا الفن(17). ونظراً لإحساسه، ربما، بصعوبة إخضاع الجمهور للدراسة التحليلية كما يُدرس النص الدرامي، أو العرض المسرحي، فإنه يعتقد بأن هذا الجمهور لا يزال، بشكل عام، عبارةً عن فكرة عامة، وتجريدية نسبياً. بيد أن ذلك لم يحل دون إدراكه بأن العلاقة بين المسرح والجمهور هي علاقة نشطة ثنائياً إذا قبل الأخير، بشكل عفوي وتام، التقاليد الفنية التي يقوم عليها المسرح، وفي مثل هذه الحال فقط يمكن التوقع بأن تصبح ردود فعل الجمهور تجاه فعل الخشبة قوةً فعالةً تندمج، ضمنياً، ولكن بشكل مؤثر، في العرض المسرحي الفعلي. ويشترط ميوكاروفسكي، لإيجاد مكان للمتلقي في العرض، الذي يبدو ظاهرياً كأنه محصور بالخشبة بحكم سيره، أن يقوم فريق العرض بتنويره بنشأة عملهم(18).
ويختم ميوكاروفسكي مقاله بمسألتين أساسيتين تتعلقان بالمتلقي، أولاهما إعلانه موقفاً يحسم، بوضوح شديد، أهمية المتلقي في رؤيته للمسرح، مفاده "أن الجمهور هو كلي الوجود في بنية العرض المسرحي"(19)، وأنه "العامل الأساسي في المسرح كالفضاء الدرامي والممثل، لأن كل ما يحدث على الخشبة موجه، بطريقة أو بأخرى، إليه"، إضافةً إلى أن فعل الخشبة "ليس وحده الذي يؤثر في الجمهور، بل الجمهور أيضاً يؤثر في فعل الخشبة"(20). والثانية إشارته إلى أفق التوقع لدى الجمهور بتعبير مقارب لهذا المفهوم من مفاهيم نظرية التلقي الذي اجترحه ياوس، وهو "الادراك المتوقع للجمهور ومزاجه في أثناء العرض"(21)، وقد تأثر بافيس بهذا المفهوم أيضاً.
وفي سياق تنظيره لخاصية التعددية التي تتميز بها العلامة في الفن المسرحي، يوضح بوغاتيرف أن هذه التعددية "تزداد بحكم أن متفرجين مختلفين يفهمون المشهد ذاته بطرق مختلفة"(22). ويشير هذا التوضيح، إلى حد ما، إلى قدرة المتلقي على التأويل، إذا ما نظرنا إلى هذا المفهوم بوصفه فن الفهم. ويضرب بوغاتيرف مثالاً بسيطاً على ذلك بمشهد مسرحي يصور الفراق، وترافق الحوار فيه موسيقى، فالمتلقي الميال إلى الموسيقى سيكون المعنى الغالب في ذهنه مرتبطاً بالموسيقى، أما المتلقي المعني بالإلقاء فسيكون العنصر الحاسم لديه هو الإلقاء، وسيكون للموسيقى شأن ثانوي(23). ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن المتلقي الميال إلى الأدب سيكون الحوار، أو بنيته الأدبية محور اهتمامه، وسيركز على تأويله، أو يبحث في دلالاته الحافة، أو الاستعارية. وفي حال كون المتلقي ناقداً متخصصاً فإن اهتمامه سيشمل هذه العناصر كلها في آن واحد.
ويبحث بوغاتيرف، أيضاً، في الشعور بالثنائية، الذي يساور المتلقي وهو يشاهد ممثلاً يعرفه، أو على علاقة به، مؤكداً على أن جميع الإشارات التي يعبر عنها الممثل، في مثل هذه الحال، تكون مفعمة بالحيوية، أولاً، وأن من المستحيل على المتلقي المطابقة بين الممثل والدور الذي يؤديه، ثانياً. وبمعنى آخر أن معرفة المتلقي للممثل تحقق عملية كسر الوهم التي دعا إليها بريخت في نظرية المسرح الملحمي. ويرى بوغاتيرف أن هذه الثنائية قد أبرزتها بوضوح جميع أنواع المسارح اللاواقعية، وكانت عقبةً في طريق تحقيق (الطبيعة المطلقة) في المسرح الطبيعي. ولذلك طالب أحد المخرجين في هذا المسرح من ممثل الدور الرئيسي في مسرحيته أن يقلل من ظهوره العلني بين الناس وإلاّ سيفقد الكثير من المتلقين الشعور بواقعية ما يتوهمون رؤيته حين مشاهدتهم الممثل ذاته بدور (الملك لير)، أو (هاملت)، ولن يتمكنوا من تخيّل أنهم يشاهدون (لير) الحقيقي، أو (هاملت) الحقيقي، وليس مجرد ممثل يؤدي هذا الدور أو ذاك(24).
وحاول أوتكار زيخ، المنظر التشيكي البارز للمسرح، أن يحلل كيفية إدراك الجمهور لمسرح الدمى، كما يقول بوغاتيرف، فتوصل إلى استنتاج مفاده: ثمة تناقض بين المفهومين لما يدركه الجمهور حسياً، إذ يمكن أن يفهم هذه الدمى إما على أنها بشر أحياء، أو كدمى لا حياة فيها. وإذا ما فهم الدمى فقط بواحدة من هاتين الطريقتين سيبرز احتمالان:
1- يمكن أن ينظر الجمهور إلى الدمى بوصفها دمى، أي أنه سيؤكد على مادتها غير الحية، عندها لن يستطيع أن يأخذ على محمل الجد حديثها وحركاتها وتعابيرها الحيوية، وستسترعي انتباهه كأشياء كوميدية غريبة.
2- يمكن أن يدرك الجمهور الدمى على أنها كائنات حية، إذا أكد على إظهارهم للحيوية (حركات وحديث وتعابير)، وفكر بها على أنها حقيقية. عندها يتقلص إدراك انعدام الحياة الفعلية للدمى ليبرز ثانيةً كشعور لشيء متعذر تفسيره، كسرٍّ يثير الدهشة في نفسه. وفي هذه الحال تؤثر الدمى في الجمهور بشكل ملغز. أما لو كانت للدمى أحجام بشرية فعلية، وكانت تعابير وجوهها كاملةً قدر الإمكان فإن طريقة تصور الجمهور لها كانت قد بعثت فيه الرعب(25). وفي ضوء سايكولوجية الإدراك الحسي للمتلقي، خالف هونزل نظرية فاغنر في المسرح التركيبي، التي أشرنا إليها سابقاً، واصفاً افتراضاتها بأنها غير صحيحة، وتحجب أكثر مما تظهر جوهر الفن المسرحي، لأنها تحيط المسرح بفنون كثيرة إلى درجة تذوب فيها ميزة التمسرح وتتلاشى، كما أنها لا تدرك حقيقة تطور المسرح، الذي وجد من دون موسيقى، أو ممثلين (إشارةً إلى مسرح الدمى)، أو عقدة، أو حوار ( إشارةً إلى المسرح الإيمائي)، أو مؤلفين. إن المشكلة مع هذه النظرية تكمن، كما يرى هونزل، فيما إذا كان المتلقي يعي الإشارات البصرية والسمعية في آن واحد، وبالحدة ذاتها، أو فيما إذا كان يركز على ناحية واحدة فقط في أثناء عملية الوعي. ولحل هذه المشكلة ينبغي، من وجهة نظره، فهم قضية وعي الإشارات الفنية على أنها حال خاصة بالوعي، فإذا كان على عقل المتلقي أن يفكر بشكل مكثف لكي يدرك القيمة السيميائية لحقائق معينة، فسيفترض، على نحو مؤكد، أن العقل سينصب على مدركات حسية ذات نوعية خاصة، بصرية أو سمعية. وإذا كان اهتمام المتلقي المركز يعي بصرياً وسمعياً فلا يمكن، في هذه الحال، الكلام عن مجموعة من الانطباعات، بل عن علاقة خاصة لنوع واحد من الوعي بآخر، وعن استقطاب هذه المدركات، فما دام البصري والسمعي يتبادلان مواقعهما على خشبة المسرح، يمكن لواحد من هذين العنصرين أن يغوص تحت سطح وعي المتلقي المهتم، فقد يدفع معنى حوار مسموع، مثلاً، بوعي المتلقي إلى إيماءة درامية، أو مظهر درامي، أو مشهد، أو إضاءة، أو غير ذلك، إلى الخلفية، أي أن انشداد المتلقي إلى معنى الحوار يشغله عن العناصر الأخرى، أو بالعكس قد تزيل مشاهدة فعل درامي المدركات السمعية (الكلمات، الموسيقى، التمتمات، وغيرها)(26).
ويمضي هونزل في مقاربة هذه المسألة ليصل إلى أن قدرة المتلقي السايكولوجية في تركيز اهتمامه الكلي على شيء محدد تتضمن، أيضاً، القدرة على إزالة أي شيء دخيل على موضوع اهتمامه من إدراكه الواعي. ويضرب على ذلك مثلاً بـ "أن يكون أحدنا غير منتبه إلى ممثلة في ثوب خيش وحول عنقها تلتف جدائل من خيوط تشع على صدرها ألواناً ذهبيةً حمراء، وتشير إلى أنها تلعب دور سميرميس، أو كليو باترا، أو أن يكون غير واع لواقع قميص ممزق لفلاح، ويركز، بدلاً من ذلك، جل طاقته البصرية على بياضه الناصع الذي حول لابسه إلى رسول من السماء، جبرائيل رئيس الملائكة، أو إلى أي شخص من الحشد السماوي مادام لطيفاً وجباراً"(27). ولا يرى هونزل أن عدم انتباه المتلقي يشكل نقيصةً فيه، أو دلالةً على سذاجته، بل برهاناً على مقدرته السايكولوجية في تركيز اهتمامه المكثف حول الاهتمامات التي حددها العرض المسرحي، ومخيلته التفسيرية. ولذلك يُعد القدرة على الانتباه المركز، وإقصاء كل شيء دخيل على تلك الاهتمامات ميزةً أساسيةً للقدرة الإدراكية للمتفرج ذاته(28).
ويربط هونزل بين متعة الإدراك المسرحي عند المتلقي والتعارض بين التمثيل العقلي والواقع، ويعتقد بأن هذا التعارض شرط أساسي، ولا يجوز أن يُفهم كنتيجة لأن المتضمن هو تركيب للتعارض، وأن الإدراك المسرحي يحصل نتيجةً لقهر هذا التعارض بين التمثيل العقلي والواقع اللذين تركّبا في فعل التفسير، الذي يحول التمثيل العقلي والواقع في لحظة مشاهدة المتلقي المشحونة بالانفعال(29).). ومثلما أعطى بوغاتيرف للمتلقين دوراً في فهم العرض المسرحي بطرق مختلفة بسبب الخاصية التعددية التي تتميز بها الإشارة في الفن المسرحي، كما أسلفنا، فإن هونزل يقرر بأن الأعمال والأفعال التي تؤدى على الخشبة أمام الجمهور تسمح بالعديد من المعاني والتفسيرات، فالصفة التراجيدية والكوميدية، أو الحيادية انفعالياً لأي فعل خاص، سواء أكان مرعباً جداً، أو من النوع التافه جداً، ليست كامنةً في الفعل كغاية له، وخاصية ثابتة، بل كمسألة تفسير ذاتي، ويضرب مثالاً على ذلك بأن "المتلقي الذي يرى شايلوك يشحذ سكيناً على نعل حذائه ليقتطع رطلاً من لحم جسم أنطونيو، ينفجر ضاحكاً وسط ترتيبات السفاح شايلوك، وقلق أنطونيو. والأدوار التي توجد في مسرحيات شكسبير لم تستثنِ أيضاً احتمال تفسيرات الجمهور لها تفسيرات متناقضةً"(30).
وهكذا يتضح لنا، من خلال عرضنا لتنظيرات سيميائيي حلقة براغ حول ديناميكية العلامات في المسرح، وفاعلية المتلقي، أن اتهام باتريس بافيس لأولئك السيميائيين بتجاهل هذين المبحثين اتهام لا أساس له من الصحة، على الرغم من أن مقارباتهم لمبحث المتلقي لا ترقى إلى مقاربات المنظرين المحدثين من أمثاله. وفي الحقيقة لا ينفرد بافيس وحده في هذا الاتهام الموجه إليهم، بل يشاطره آخرون في ذلك، منهم سوزان بينيت، في سبيل المثال لا الحصر، كما سنرى في المبحث الخاص بها.
2- التحليل الدراماتورجي وتمثّل نظام العلامات
نعود، بعد هذا الاستطراط، إلى بافيس، الذي يرى أن التحليل الدراماتورجي (وهو عنصر حتمي وجوهري في النظرية المسرحية، وينطوي على نموذج جدلي يستمد مقولاته من جماليات الإرسال والتلقي) الذي يقوم به المخرج (في حال تحويل النص إلى عرض)، أو الذي يقوم به المتلقي (في حال تلقيه للعرض في شكله الإخراجي النهائي) يقوم على تمثّل نظام العلامات المتقابلة، ويصبح العمل الدرامي، على وفق هذا التحليل، سواء أكان نصاً نقرأه، أم عرضاً نتلقاه، عمليةً وسيطةً بين الإرسال والتلقي تنتظم من خلال ثلاثة مفاهيم جوهرية:
1-2- التجسيد
يحتل مفهوم التجسيد(*) الظاهراتي الحيز الأكبر من اهتمام بافيس، وهو يلخص، من وجهة نظره، مفهوم التأويل من خلال القارئ، أو المتلقي، أو الجمهور في شكله الجماعي. وقد أخذ هذا المفهوم عن نظريتي إنغاردن وفوديكا حول التلقي، ولتوضيح مفهوم التجسيد في سياقه الظاهراتي لابد من وقفة قصيرة على دلالته أولاً عند كل من هوسرل، إنغاردن، وياوس. يعتقد هوسرل أن الفلسفة تبدأ من تفحص المرء الدقيق والحذر لعملياته العقلية. ويهدف ذلك إلى التعرف على العناصر المنطقية الموضوعية في الفكر عبر دراسة فعل الوعي وبنيته. ويرى أن الوعي يكون واعياً بشيء ما دائماً، ويستخدم مصطلح )القصدية) لوصف فعل الوعي، أو الفعل القصدي، وأن الحدس المتجسد بالفعل القصدي والموضوع القصدي يمكن تحليله وتقسيمه إلى طبقات بالاستناد إلى منطق شديد الدقة بعد أن يزيل المرء من عقله الافتراضات الشائعة كلها المتعلقة بالعمليات السايكولوجية. وفي سياق فحص هوسرل لأنماط الوعي ووظائفه، فإن أكثر ما يهم النظرية الأدبية هي الوظيفة التي يتمكن فعل الوعي، من خلاها، "إكمال" مواضيع إدراكه الحسي عبر إدراك منظوراتها كلها، التي لا تكون "مرئيةً" مطلقاً، من وجهة نظر أو "جانب" معين. ويحدث هذا التجسيد لكل من مواضيع الإدراك الحسي، ومواضيع الفكر المجردة(31). وتعتمد نظرية إنغاردن "على إطار شكلي يقدمه للقارئ يحتوي على نقاط، أو مواضع فراغ، أو إبهام يقوم القارئ بملئها، ويسمي إنغاردن تلك المناطق الفارغة (تجسيدات)، وهي تمثل جوهر الخلاف بين بنية النص وما يضيفه القارئ إليه بتجسيداته"(32). ويرى إنجاردن أن القارئ، في أثناء بذله الجهد "من أجل بناء معنى متماسك من النص فإنه سوف يختار عناصره وينظمها في وحدات كليّة متصلة، مقصياً بعضها ومقدّماً بعضها الآخر، و"مُمَلمِساً" [مجسداً] بعض المفردات بطرائق معينة، وسوف يحاول أن يقبل منظورات مختلفةً ضمن العمل وفي وقت واحد، أو أن يتحول من منظور إلى منظور لكي يبني "وهماً" متكاملاً"(33). ويذهب ياوس إلى أن "النص الأدبي بنية تقديرية، ولذلك فهو يحتاج إلى دينامية لاحقة تنقله من حالة الإمكان إلى حالة الإنجاز، ومن حالة الكمون إلى حالة التحقق [التجسيد]"(34). ونفهم من ذلك أن المتلقي، في اصطلاح نظرية التلقي، يجعل العمل الأدبي "مجسداً"، وليس هذا الأخيـر نفسه سوى سلسلة منظمة من العلامات السوداء على الصفحة، فمن دون مساهمة القارئ الفعّالة المستمرة هذه لن يكون ثمة عمل أدبي على الإطلاق. ومهمـا كانت المتانة الظاهرة لأي عمل أدبي فإنه لا يخلو من "فراغات"، أو إنه مليء بالعناصر غير المحددة ، وهي عناصر يتوقف تأثيرها على تأويل القارئ، وتتعدد وتختلف، بل ربما تتضارب طرق تأويلها، كما يقول إيجلتون(35). ولكن بافيس يتحاشى النظر إلى التجسيد بوصفه نتاجاً لفعل تداولي يملك القراءة الجيدة الوحيدة للنص، كما هو الحال في بعض المحاولات التي تستلهم أطروحات التداولية(36)، وذلك لأنها تضطلع بتحليل النص تحليلاً يستبعد المعايير التاريخية لإرساله وتلقيه. ولذا فإنه من المحال تفسير لماذا يلاقي النص نفسه، في أثناء مساره التاريخي، مجموعة من التجسيدات المختلفة، بل والمتباينة تماماً(37). ويقترح بافيس، لملء الفجوة المصطنعة بين الإرسال والتلقي، نموذجاً لا يخضع لشكلانية تنحصر في العلاقة المجردة بين العلامة وما تشير إليه، ولا لمفهوم قاصر عن المحاكاة يعجز عن تنظيم النص إلى وحدات دلالية يقال إنها تمثّل الواقع. ويستلهم بافيس هذا النموذج، الذي يسميه (دورة التجسيد) (على غرار الدائرة الهيرمنيوطيقية أيضاً)، من تصور ميوكاروفسكي (على الرغم من اتهامه له ولزملائه في حلقة براغ السيميائية، كما أسلفنا، بتجاهل دور المتلقي في المسرح) الذي قدمه في مقال بعنوان (الفن كحقيقة سيميولوجية)، وأكد فيه على أن كل عمل فني هو علامة مستقلة تنطوي على:
1- وجود ماهيته كرمز واضح محدد. 2- موضوع جمالي له معناه ودلالته. 3- علاقته بالمدلول، وهي علاقة تأخذ في الاعتبار السياق الكلي للظواهر الاجتماعية (بما فيها من علم وفلسفة ودين وسياسة واقتصاد...الخ) الموجودة في مجتمع بعينه. ويضع بافيس، من خلال هذا النموذج، الذي يشتمل على العلاقة بين الفن والمدلول، تصوراً للإرسال والتلقي يتمثل بالخطاطة الآتية(38):
ويوضح بافيس هذه الدورة بالنقطتين الآتيتين:
1- يمثل الشكل رقم (1) البنية الدالة للعمل الفني.
2- يمثل الشكل رقم (2) العلاقة بين العمل الفني (الدال- Sa) والمضمون الجمالي (المدلول- Se).
وتقترن هذه العلاقة بمعرفة السياق الكلي للظواهر الاجتماعية (Sc) (بما فيها من علم، وفلسفة، ودين، وسياسة، واقتصاد،...إلخ). ولكي يحصل متلقي العلامة (قارئاً كان أو مشاهداً) على دلالة للعمل الفني تستقر في الوعي الجمعي يلزمه بافيس أن يحدث تلاقياً بين الدال والمدلول.
وبعد سلسلة من العمليات (مثل التخييل، وتحويل النص إلى أيديولوجيا، وتحويل الأيديولوجيا إلى نص) تحدث تلك العلاقة بين العمل الفني، كدال، والموضوع الجمالي، كمدلول لإنتاج علامة مستقلة تمثّل تجسيداً للعمل الفني (سواء قرأناه، أو تلقيناه), وذلك في سياق اجتماعي معين.
ويكشف بافيس في هذه النقطة عن تطابقه التام مع أطروحة موكاروفسكي التي تلزم الدراسة الموضوعية لظاهرة الفن بأن "تنظر إلى العمل الفني على أنه إشارة مؤلفة من: 1- رمز حسي ابتدعه الفنان (= عند بافيس الدال- Sa)، 2- معنى (أي موضوع جمالي) كامن في الوعي الجمعي (= عند بافيس، أيضاً، المضمون الجمالي، أو المدلول- Se)، 3- علاقة بالشيء المرموز إليه. وهذه العلاقة تشير إلى السياق الكلي للظواهر الاجتماعية (= عند بافيس، أيضاً، السياق الكلي للظواهر الاجتماعية- Sc)"(39).
ولكن دورة التجسيد تثير، في شكلها هذا، عدداً من الإشكاليات، التي تحتاج إلى تأمل، وهي:
1- تحدد الدوال قبل دورة التجسيد وتشكلها، فالدال قبل دخوله في دورة التجسيد لا يتشكل من خلال السياق الاجتماعي، بل يفرض نظامه الخاص على من يدركه.
2- لا يجري تحول الدال إلى السياق الاجتماعي بشكل مباشر، بل يحدث على مستوى النصية الذاتية أولاً، ثم على مستوى النصية الأيديولوجية.
3- يُعدّ السياق الاجتماعي نتاجاً للعمل الفني، له مرجعيته، فهو يشير إلى عالم ما، ويصاغ، أيضاً، من خلال ظروف تلقي العمل. وهكذا فإن هذا السياق الاجتماعي إما ذلك السياق الذي يوجد في إطاره مبدعو العمل الفني، أو موقف التلقي الذي يجري من خلاله إدراك العمل.
ويرى بافيس أن ما يترتب على ذلك هو أن نشاط المتلقي يتجه إلى اتجاهين مختلفين:
أولاً: في محاولته لتمثل الدوال يسعى إلى اكتشاف المدلولات المحتملة.
ثانياً: إن المدلولات التي يستخلصها من خلال تأويله الخاص يسعى إلى تأكيدها، وتلمس آثارها في الدوال. ولا تحدث هذه العملية بصورة مستقلة عن العمل الفني، بل تظهر اقتران الدوال بالسياق الاجتماعي، والأيديولوجيا، التي هي ليست محض مجموعة من القناعات الموجودة فوق العمل، أو خارجه، بل هي عملية سمطقة وتشفير لما يشير إليه الدال.
وهكذا يجد بافيس أن العلاقة تشكل تجسيداً للعمل الفني، ويمكن الربط بين مدلول محدد (يمثّل تلقياً معيناً من جانب القارئ، أو المتلقي في إطار السياق الاجتماعي) والدال. وتسفرعملية الربط بين المدلول والدال عن عملية التجسيد.
4- ينشأ الجوهرالذي ينتمي للوعي الجمعي من خلال تقاطع المدلولات المختلفة، مكوناً، في لحظة تاريخية معينة، تجسيداً. ويحدث بعد ذلك الترابط بين هذا الجوهر ودال معين.
5- ثمة جانب تفتقر اليه دورة التجسيد وهو السعي إلى الكشف عن الكيفية التي يشير بها الدال إلى المدلولات، وذلك من خلال السياق الاجتماعي، بهدف التأكد من الفرضية القائلة بتمثل بنية العمل في مدلولات معينة.
6- إن عناصر هذه الدورة تُعدّ كلها من المتغيرات، وذلك لأن السياق الاجتماعي يمثّل جملة المعايير الأدبية والاجتماعية، والتقاليد الفنية، والوحدات الأيديولوجية التي يمكن أن يمثلها النص. أما الدال فهو يُعدّ، أيضاً، عنصراً متغيراً لأنه ينطوي على أبعاد مختلفة، ووحدات دالة ترتبط فيما بينها بطرق مختلفة. وكذلك المدلول يُعدّ متغيراً لأنه يتأثر بالتغيرات التي تحدث في السياق الاجتماعي والدال.
وتتعدد تبعاً لذلك تجسيدات النص الواحد، إلاّ أنها جميعاً قابلة للتفسير رجوعاً إلى التغيرات الطارئة على الدالوالسياق الاجتماعي.
7- يجب أن يحدث نوع من المقارنة بين العمل الفني وتجسيداته المختلفة الناتجة عن القراءات المتباينة لهذا العمل (وقد يحدث ذلك في أثناء لحظة التجسيد المسرحي لعمل ما، واستقبال المتلقي لهذا التجسيد).
8- يُعدّ العمل في شكله الأول، قبل التجسيد، بنيةً نسقيةً، وهذا يعني أن العديد من جوانب العمل، مثل الأفكار والواقع المجسد تتضمن آفاقاً غير محددة، ويجري التخلص من هذه الآفاق جزئياً في عملية التجسيد. إلاّ أن التجسيد يبقى نسقياً، أيضاً، ولكن بدرجة أقل من العمل ذاته(40).
ولكن ما هي الأسس التي تقوم عليها عملية التجسيد في المسرح؟
يجيب بافيس على ذلك بالتفريق بين مسألتين:
1- التجسيدات الدرامية التي نراها مباشرةً بأنفسنا.
2- التجسيدات التي تصل إلينا بشكل غير مباشر من خلال الأشكال التوثيقية المختلفة، مثل المراجعات النقدية، والمتابعات الصحفية، والملاحظات التي يقدمها الكاتب المسرحي، أو المخرج عن العرض من منطلق قراءته الخاصة للعمل؛ ويأتي بعد ذلك دور المتلقي الذي يقوم بتجسيد التجسيد الأول (أو القراءة الأولى) للنص المتمثل بالإخراج المسرحي.
ولكن التجسيد الذي يصل إلينا بشكل غير مباشر، أو من خلال وسائط مكتوبة، أو سمعية، أو مرئية لا يمثل التجسيد الأول تمثيلاً كاملاً. ومن خلال عملية استعادة التجسيد الأول تجري مقارنة تلك الوسائط وتحليلها بهدف استيعاب البنية الجوهرية التي تحدد عملية التجسيد(41).
1-1-2- التجسيد والوصف
يشير بافيس إلى أن وصف أي عرض مسرحي ينطوي على نظرية للوصف تسعى إلى الإجابة عن أسئلة من قبيل: ما هي اللغة الشارحة المطلوب استخدامها؟ وما هي الوحدات التي يفضَّل اختيارها؟ ويُعدّ الوصف عملية تحول تداخل سيميائي من نسق ما (وهو النسق السمع- مرئي في حال التجسيد الدرامي) إلى نسق آخر (رمزي، أو أيقوني). ويرى بافيس أن هذا النسق الوصفي يتخذ إما شكلاً مكتوباً أيقونياً، أو وصفاً لفظياً (شكل اللغة الشارحة). ولكل من هذين الشكلين حسناته وعيوبه، فالأول لا يفعل أكثر من حفظ العرض لمتلقي المستقبل، الذي سيجد نفسه مضطراً إلى أن يقوم بنفسه بعملية الوصف والتجسيد، كما أنه يعتمد على نظام تدوين يستخدم رموزاً محددةً، لذا يلزم تشفير هذا النظام الوصفي بطريقة دقيقة. إلاّ أنه تصعب قراءته على من لا يعرف شفرة نظام التدوين. وفي كل الأحوال يقوم المتلقي بقراءة هذا الشكل الأيقوني، وتحويله إلى نظام لفظي. وعلى الرغم من الدقة التي تميزه، فإنه يقف عاجزاً أمام أسئلة مثل: ما هي المبادئ التي يُبني على أساسها نص العرض؟ وإلى أي درجة يتسم هذا النص بالاتساق؟ وكيف يمكن له أن يتطور متخذاً أشكالاً وصيغاً مختلفةً؟ أما الشكل الثاني فإنه يخضع لتأويل خاص من شأنه أن يصوغ نصاً جديداً. إلإّ أنه يُعدّ أكثر دقةً.
وفي هذا الصدد يؤكد بافيس على أن اللغة، في دقتها ومرونتها، تتخذ شكل الموضوع الذي تقوم بوصفه، كما أنها تسمح بانتقاء المبادئ السيميائية للإخراج الدرامي، والتي تمكن المتلقين من القيام بعملية المزج التركيبي الخاص بهم(42).
ونرى أنّ تفضيل بافيس، في هذه الفقرة، شكل الوصف اللفظي (المنطوق) للعرض المسرحي على الوصف المكتوب (الأيقوني)، بإقراره أن الأول أكثر دقةً من الثاني، مفارقة غريبة، وخاصةً أنه لا يجهل "أن الكتابة قد غيرت شكل الوعي الإنساني أكثر من أي اختراع آخر"، كما يقول والتر أونج، في كتابه (الشفاهية والكتابية)(43)، بل إن هذا التفضيل يدعو إلى التساؤل عما إذا كان بافيس يؤثر النظرية الشفاهية على النظرية الكتابية، أو "أسطورة أسبقية اللغة الشفاهية على اللغة المكتوبة "(44) أم لا؟ وإذا كان الجواب بأنه كذلك، علماً بأن سياق كلامه يوحي بتسويغه للشفاهية، على الرغم من اعترافه بأن للوصف اللفظي عيوباً أيضاً، فإننا نميل إلى الاعتقاد بأنه يصدر، في عملية الإرسال والتلقي، عن رؤية تتمركز حول الصوت والذات، تنحو إلى "ميتافيزيقيا الحضور"، مستعيدةً قضية النطق والسمع، أو حضور الكلام الحي الذي يقترن بالناطق، من موروثه الفلسفي والديني الذي يقدس الكلام الشفاهي، و"يعطيه الأولوية بطرق عدة"(45)، بوصفه يمثل "مركزية الصوت"، حسب مفهوم دريدا، الذي يشير إلى أن "اللوغوس"، أو الكلمة الصوتية أمر أولي في الثقافة الغربية. ويبدو أن ميل بافيس إلى الوصف المنطوق للعرض المسرحي قد أنساه أن "الخطاب المكتوب منفصل عن مؤلفه"(46)، وهذا ما يعطي ميزةً للوصف المكتوب، ويجعله أكثر موضوعيةً وحياديةً من الوصف المنطوق، فالمرء حين يصف حادثةً لحشد من الناس، بطريقة ارتجالية، قد يضطر إلى استخدام أسلوب مقيد بالسياق، ويراعي الديناميات النفسية الخاصة بالتعبير الشفاهي، وقد يكون عرضةً للتشتت عندما تستدعي كلمة من الكلمات سلسلة من التداعيات التي يتبعها، فيقع في هوة الاطناب، في حين أن الكتابة "تخلق ما أسماه بعض الباحثين لغة "طليقةً من السياق" (هيرش)، أو "خطاباً مستقلاً" (أولسن)"(47). ويعيد بافيس، في هذه الفقرة أيضاً، على نحو ملتبس، ملاحظة دي سوسير أن للكتابة "فوائدها، وعيوبها، وأخطارها" المتزامنة، التي ذكرها في سياق كلامه عن استخدام الكتابة كثيراً لتمثل اللغة، أو التعبير عنها، على الرغم من أنها لا تمت بصلة إلى النظام الداخلي للغة(48)، وهي ملاحظة عبر فيها سوسير عن عمق وعيه بالانفصال الأساسي بين الكتابة واللغة المنطوقة.
2-1-2- التجسيد والتأويل
يبدو مفهوم التجسيد مفيداً، في رأي بافيس، بوصفه أدةً ضمن أدوات تأويل النص أو إخراجه، كما يمكن استخدامه عند عقد مقارنة بين عدد من القراءات، أو أشكال الإخراج الممكنة. ولكنه، على الرغم من ذلك، يدعو إلى تجنب اختزال التجسيد، كما فعل كل من إنجاردن وفوديكا، إلى ردود أفعال سايكولوجية فقط تصدر عن فرد نتيجة لتعرضه للعمل الفني، أو إلى شكل بسيط في وعي الذات المدركة، ذلك لأن هذا الشكل لا يكتسب سمة الوجود من دون أن يكتسب شكل خطاب ملموس، سواء كان ذلك في هيئة تعليق، أو مقال، أو مراجعة نقدية، أو ظهر في شكل إخراج مسرحي يتلقاه جمهور معين في حال المسرح. ولا يقصد بافيس بالإخراج المسرحي هنا ذلك الإخراج الذي يقوم به المخرج، بل الذي يضطلع به المتلقي حين يقوم بمزج تركيبي، وإعادة تركيب عناصر العرض، مقدماً من خلاله تصوره الخاص للعمل المسرحي.
وبهذا المفهوم يعد بافيس وصف التجسيد المرحلة الأولى، ليس إلاّ، في عملية تحديد معنى نص العرض، وعلى الرغم من أهمية هذه المرحلة، فإن التجسيد يجب أن يوضع في سياقه التاريخي الذي يوضح كيفية تلقي جمهور معين العمل في لحظة معينة. ومن ثم فإن التجسيدات المختلفة للعمل الفني لا يمكن دراستها وتحديدها إلاّ في ضوء التاريخ، وعملية التأويل التي يقوم بها المتلقي. وتلتقي أطروحة بافيس هنا مع أطروحة بول دي مان التي تقول إن "فعل الفهم فعل زماني له تاريخه"(49)، وهي تعود، أساساً، إلى نظرية هايدغر في الدائرة الهيرمنيوطيقية (التأويلية)، حيث أن الحوار بين العمل والمؤول لا ينتهي، فالفهم التأويلي دائماً، وبسبب طبيعته الخاصة، يتخلف إلى الوراء، أي أن فهم المرء لشيء ما يعني إدراك أن المرء كان يعرفه دائماً، ولكنه، وفي الوقت نفسه، يعني مواجهة سر هذه المعرفة الخفية، ولا يمكن أن يدعى الفهم مكتملاً إلاّ حين يكون على وعي بمأزقه الزماني(50).
ويميز بافيس بوضوح بين الدراسة الجادة لتجسيدات العمل، وبين كتابة تلخيص للتعليقات التي يثيرها ذلك العمل. ويرى أن هذا التلخيص، عادةً ما، يكون غير دقيق لأنه لا يخبرنا الكثير عن عملية الإحلال التي تحدث في أثناء التجسيد، كما لا يخبرنا بشيء عن العلاقات الجديدة التي تنشأ بين الدال والسياق الاجتماعي والمدلول. وعلى الرغم من أهمية دراسة سلسلة التجسيدات لعمل ما سوسيولوجياً من خلال النصوص النقدية، فإنها لا تساعد في تحليل العمل الفني، أو تأويله. وإذا كانت عملية الإخراج، التي تسهل دراسة تجسيد نص درامي، هي ذاتها عملية تجسيد قائمة على التجسيد الذي يقوم به المخرج عند قراءته للنص وتحليله، فإن من الصعوبة بمكان دراسة التجسيد الذي يقوم به المتلقي، كما يرى فوديكا، لأننا، في مثل هذه الحال، لن نجد، على حد قوله، إلاّ معلومات غير مباشرة لا تفصح بشكل دقيق عن العمليات التي يمر بها المتلقي حتى يصل إلى تجسيده الخاص للعمل.
ويؤكد بافيس أن هذا التداخل المعقد بين سلسلة التأويلات المتشابكة يجعل من الصعوبة بمكان التمييز، أو الفصل بين:
1- قراءة النص (حرفياً).
2- عملية التحويل المسرحي التي تحدث من خلال الإخراج.
3- الروابط بين هاتين العمليتين (أي القراءة والتحويل المسرحي).
ويرى بافيس أن عملية قراءة الإخراج المسرحي (أو قراءة المسرح على حد تعبير آن أوبرسفيلد) تتضمن:
1- قراءة النص الدرامي الأصلي (وتسمى هذه العملية، أحياناً، الإنصات إلى النص).
2- قراءة نص العرض الذي يتضمن النص الدرامي.
3- قراءة القراءة التي يقوم بها المسرحيون للنص الدرامي
ولكنه يلاحظ أن هذه العمليات ليس من الضروري حدوثها على نحو متزامن(51).
3-1-2- الآفاق غير المحددة
يعترف بافيس بأن نظرية التجسيد تبدو غامضةً إلى حد ما فيما يتعلق بتناولها للعمليات التي تحدث في أثناء عمليتي إرسال النص وتلقيه، وذلك لأن هذه النظرية تنحصر في محاولة الربط بين سلسلتين من التغيرات: تغيرات في المعايير الجمالية والاجتماعية داخل السياق الاجتماعي، وتغيرات في الكيفية التي تتجزأ بها الدوال، ويمتزج بعضها ببعض. ويوضح بافيس أن هذه النظرية ترتبط، خاصةً في كتابات أنجاردن، الذي يعد أول من قدم فكرتها، بالتعرف على الآفاق غير المحددة داخل العمل، فما يجري تجسيده، بالنسبة لأنجاردن، هو الأشكال المختلفة للواقع الفعلي، وليس بنيةً جديدةً فقط، أو علاقة جديدة بين الدال والسياق الاجتماعي. وأشكال الواقع، تلك التي يجري تجسيدها، هي غير محددة بشكل كامل داخل النص، الأمر الذي يستدعي وجود دور فعال لقارئ يقوم بملء هذه الفجوات. ويشير بافيس إلى قول أنجاردن إن المعرفة المتزايدة بالواقع الذي يشير إليه النص، من خلال فعل القراءة الفردي، هو ما يمكّن القارئ من ملء الفراغات داخل النص. ويستنتج من ذلك أن نظرية التجسيد، حسب أنجاردن، تركز على أهمية وجود معرفة بما تشير إليه العلامة في أثناء عملية بناء العالم الخيالي. ولكن من أين نحصل على هذه المعرفة لملء تلك الفراغات، وكيف توضع داخل النص؟ يجيب بافيس، استناداً إلى رؤية أنجاردن، بأن القارئ يحصل عليها من داخل النص ذاته. وتتوقف مسألة إعادة وضعها على المنهج المتبع في القراءة.
ويؤكد بافيس على إمكانية النظر إلى الفراغات، أو الآفاق غير المحددة داخل النص بوصفها مصدراً لعلامات استفهام، أو نقاط الالتقاط التي يتلاقى فيها النص وقارئه، حيث لا يبوح الأول، في هذه الآفاق، كما ينبغي عليه أن يبوح به، وذلك إما لأن خطاب النص يُعدّ على درجة كبيرة من الوضوح بحيث يمتنع معها التصريح، أو لأن أيديولوجية النص تخفي تناقضاً اجتماعياً يشير إليه النص من دون تبني موقف معين(52).
2-2- التخييل
تهتم نظرية التخييل النصي، في رأي بافيس، بدراسة قواعد المحادثة وقوانينها، وتحليل الخطاب(53) في إطار الاتجاه التداولي، وخاصة عند تحليل النصوص الدرامية، والإخراج الدرامي بوصفه استراتيجية لفعل كلام، أو موقف تلفظ، حسب تعبير آن أوبرسفيلد، على أساس أن موقف التلفظ التخيلي يلتحم به موقف تلفظ مسرحي(54). وتخضع هذه النظرية لفاعلية المتلقي، على أن يجري ذلك في إطار قدرته على تكوين، أو صياغة نظرية، أو تصور للنص(55).
2-3- التعبير عن أيديولوجية النص
ينطوي هذا المفهوم، كما يرى بافيس، على إحداث تلاقٍ بين المعايير النصية، في إطار الاتجاه الشكلاني، والمعايير الاجتماعية من خلال العلاقة بين النص والأيديولوجيا(56). ولكنه يجد أن ثمة صعوبةً تكتنف عملية تحويل النص إلى أيديولوجيا تكمن في مدى إمكانية:
1- وصف الكيفية التي تتشكل بها الأيديولوجيا، وتتحول إلى نص له وحداته غير المطردة، والتي تتخلل أي نص أدبي.
2- الكيفية التي يقدم بها النص الأدبي طريقةً لقراءة النص الاجتماعي، أي الأيديولوجيا التي سبق أن تجسدت، والتي تحتوي، أيضاً، على وحدات أيديولوجية توجد في نصوص اجتماعية وأدبية أخرى(57).
3- توجيه المتلقي
قد يبدو مفهوم توجيه المتلقي، أول وهلة، كما يشير بافيس، وكأنه يباعد بين جماليات الإرسال وجماليات التلقي، إلاّ أنه يعتقد بأن هذا التوجيه يوضع داخل النص كوسيلة ملموسة لاستثارة تلقٍ جيد، ولا يستخدم تعبيراً عن ظاهرة قصدية المؤلف، بل كآلية نصية يجري توظيفها في استراتيجيات معينة للقراءة، [وهذا يشير إلى مفهوم المتلقي الضمني] فالإبهام والوضوح يتجاوران جنباً إلى جنب داخل النص، ولذلك فإن وجود أي موجه لعملية التلقي في النص لا يُعدّ كافياً، إذ إن درجة وضوح هذا الموجه تجاورها داخل النص آفاق أخرى، تتسم باللاوضوح واللامقروئية، ومن ثم فإن المسألة هي مسألة إدراك للتوجيه الموجود في النص، وللمعايير الأدبية والاجتماعية، الأمر الذي ينتج عنه تغيير وتعديل في عملية القراءة، وتطور في التجسيدات المختلفة. ومما يراه بافيس جديراً بالذكر هنا أن كل من القارئ والنص يلتقيان عند مدرك ثقافي سابق، أو بنية سابقة يدركها القارئ في الحال حينما يجري توجيهه إلى الأيديولوجيا، أو إلى نصوص أخرى. أما المعايير الأدبية والاجتماعية فهي ترتبط، أيضاً، بالأيديولوجيا، وعملية التناص، وتطور التقاليد الأدبية والمسرحية، والعلاقات الاجتماعية، وهذا يضمن وجود حركة جدلية بين تجسيد معين (دال/ مدلول) وسياق اجتماعي معين، وتعتمد هذه الحركة الجدلية على التباينات في المحتوى الاجتماعي، تلك التباينات التي تؤدي بدورها إلى وجود تباينات في التجسيدات المختلفة(58).
ويؤكد بافيس على أن آليات توجيه المتلقي في المسرح تتسم بالنسبية فيما يتعلق بقدرتها على التكيف والتعديل من تجسيد إلى آخر، وتختص هذه الآليات بالجوانب الآتية:
1- التوجيه القصصي. وهنا يعتمد المتلقي على المنطق الذي يوجه الخط العام للقصة، محاولاً وضع المَشاهد الغامضة في إطار الحبكة.
2- التوجيه الخاص بالشكل المسرحي. وهنا يعتمد المتلقي على معرفته للقواعد البنائية التي تميز الأشكال المسرحية المختلفة.
3- التوجيه الأيديولوجي، الذي يقيم، من خلال قوانين إمكانية الاقتراب، أو الوصول نوعاً من العلاقة بين العالم التخيلي للعمل الفني ومرجعية المتلقين.
ويرى بافيس أن أفضل مثال على نظرية الاقتراب هو تلك الفقرة من كتاب جان جاك روسو، التي تحمل عنوان (خطاب إلى داليمبير)، والتي يقول فيها: "على كل مؤلف يسعى إلى تصوير أشياء غريبة عن قرائه أن يحرص على تكييف ما يكتبه بحيث يناسب القراء، ومن دون ذلك الحرص لن يُكتب لأي مؤلف النجاح"(59).
ويبدو أن بافيس قد تأثر، في تبنيه لمفهوم توجيه المتلقي بشكل عام، والتوجيه الأيديولوجي بشكل خاص، باتجاه التلقي الذي ظهر في ألمانيا الشرقية (مانفريد نومان وأصحابه)، والذي يؤمن بالتصورات الماركسية الاجتماعية، إذ كان أصحاب هذا الاتجاه يعتقدون بأن على العمل الأدبي أن "يقود التلقي ويوجهه"، أي أن المؤلف يوجه عمله الأدبي وجهةً قادرةً على إحداث عمليات الاستجابة والتواصل معه، فـ (نومان) يرى أن العمل الفني هو نتاج نشاط من خلاله يدخل الكاتب، حتماً، في علاقة لا تقتصر على الواقع ا