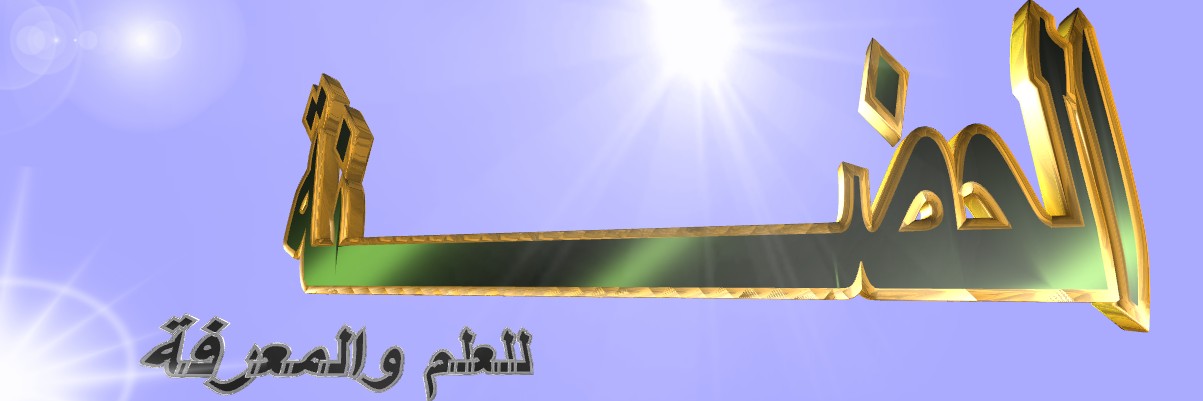قدمة حول الأجناس الأدبية
الجنوسة
لم يطرح أي مفهوم من المفاهيم الحديثة على المستويين الدلالي والإجرائي من الإشكالات كما طرحه مفهوم الجندر أو الجنوسة بسبب تغير استعمالاته واختلاف استعمالاته تاريخياً ما جعله موضع اختلاف كبير بين الدارسين والنقاد، إذ استعمل هذا المصطلح لتحديد الاختلافات بين الرجال والنساء على مستوى الوظيفة الاجتماعية. ومن أجل الوقوف على السياقات المختلفة التي اندرج ضمنها هذا المصطلح، والدلالات المختلفة التي حملها تاريخياً، وعلاقاته بمفهوم الجنس واللغة يحاول ديفيد جلوفر وكورا كابلان في كتابهما الهام “الجنوسة (الجندر)” أن يتتبعا المسارات المختلفة لهذا المفهوم تاريخياً، أو كما يسمياها التواريخ المجنوسة والسياقات المجنوسة التي كشفت عن وفرة لغوية زادت من تشويش المفهوم، وجعلت الاتفاق على دلالاته صعباً، فالدور الجنوسي أو الهوية الجنوسية مثلا هما مفهومان جديدان نسبياً ظهرا في بداية عقد الثمانينات من القرن العشرين، في حين أن الاستعمال المبكر لمفهوم الجندر يعود لأيام تشوسر في القرن السابع عشر.
المعاني الحديثة للمصطلح
يؤكد الباحثان في مقدمة الكتاب أن الاستعمال الحديث للمصطلح لا يزال يحمل آثار الاستعمالات القديمة له، إذ يستمر في حمل وظيفته كمصطلح نحوي إلى جانب كونه يعبر عن جنس الشخص بالرغم من أنه لم يعد يستعمل كمرادف للفعل الجنسي، ذلك أن الجنسانية اتخذت في دلالاتها منذ القرن التاسع عشر بوصفها موضوعاً جديداً للمعرفة العلمية والشعبية دلالة تجاوزت بها مفهوم الجنس مع تداخلها الوثيق مع جميع جوانب الحياة الاجتماعية، حيث تجاوزت كونها تدل على الطبيعة البشرية باعتبارها مركزا للذة والرغبة. ولكي يتم فهم تغير دلالات المفهوم يحاولان تأمل بعض الأمثلة المستمدة من الميثولوجيا والثقافة الغربيتين كما تجلت في حالة الخنثى، لأن الجسم البشري ظل حتى القرن التاسع عشر يُفهم على أنه جسد من لحم واحد تكون فيه الاختلافات الجنسية مسألة درج أكثر مما هي مسألة نوع. ولعل الاستخدامات الحديثة للمفهوم توضح أن الحياة الجنسانية قد أخذ ينظر إليها على أنها أكثر من مجرد مجموعة من الإحساسات.
ويشير الكتاب إلى أن بداية استعمال مفهوم الجندر gender بوصفه يشير إلى الجوانب الاجتماعية والثقافية للاختلاف الجنسي غير معروف، وإن كان معروفا في علم الجنس منذ أوائل ستينات القرن الماضي.
الجنوسة والعلم الجنسي
يستعمل مصطلح الجنوسة عند كومفورت للدلالة على التنوع الجنسي في أساليب السلوك بين المجتمعات لكن التنظير للفارق بين الجنس والجنوسة تظهر في كتابات المحلل النفسي روبرت ستولر التي أكد فيها أن الصفات الجنسية الجسدية للشخص والمواقف العقلية وموضوعات الرغبة تتغير بشكل مستقل عن بعضها البعض، كما ميز بين الهوية الجنوسية والدور الجنوسي في الحياة البرانية والجوانية للشخص. لقد استعملت أفكار ستولر بطرق جديدة في مرحلة الإحياء الهائل للسياسة النسوية في أميركا وأوروبا نهاية الستينات من القرن العشرين فقد عملت الناقدة الثقافية روبن على كشف القناع عن تصور للطبيعة تقييدي وناقص، وعلى تحرير التنوع الإنساني لأنه أكثر طبيعية من قيود العرف الاجتماعي عندما يتم إزالة العوائق الثقافية التعسفية والاصطناعية، لأن المفوهمين مقولتان ثقافيتان والجنس والجنوسة مفهومان متداخلان بالضرورة.
وحول العلاقة بين الجنوسة واللغة يتحدث الكتاب عن موقف الكاتبة الفرنسية مونيك فيتنيغ المتجذر في النظرية المادية للغة حيث المفاهيم والرموز فيها ليست سوى مجرد أفكار أو علامات عائمة، بل لها تأثيرات حقيقية على الذوات الفردية، كما أن الجنسانية الغيرية تنظم العلاقات الإنسانية وإنتاج مفاهيمها وكل السيرورات التي تقوي الوعي، الأمر الذي يجعل علاقات الجنوسة لا يمكن مساواتها أبدا لأن مقولتي رجل وإمرأة تعرفان بأنهما لا متناظرتان من البداية، بل تلعب اللغة دورا حاسما في استمرار الاختلال فالمرأة التي تتعلم أن تسمي نفسها امرأة تذعن بشكل ضمني للامتيازات التي يتمتع بها الرجال، والمرأة كي تصبح ذاتا كلية يجب عليها أولا أن تجري قطيعة مع فرضيات الجنسانية الغيرية. وإذا كانت الجنوسة قد استعملت غالبا كمقولة سوسيولوجية بالدرجة الأولى ، فإنها أغفلت دور اللغة معتبرة إياها ذات دور ثانوي ما جعل الكاتبة فيتيغ تسعى إلى تحديد موقع الجنوسة داخل اللغة لأن الضمائر الشخصية وضمائر الفاعل هي التي تشكل المدخل إلى اللغة، والكلمات هي التي تحدد موقعنا داخل الخطاب .
الأنوثة والنسوية
وعن العلاقة بين الأنوثة والنسوية يشير الباحثان أولا إلى عدم القدرة على تعريف الأنوثة بوصفها مجموعة من الصفات المنسوبة إلى الإناث المجنسات بيولولجيا، وفي ضوء ذلك يحاولان الإجابة عن ماهية صفات الأنوثة وإلى أي حد تكون أية طبعة مفترضة من الأنوثة طبيعية أو ثقافية ولذلك يستعرضان مفاهيم فرويد حول الأنوثة والذكورة ويؤكدان أن معنى المرأة بيولوجيا وسيكولوجيا واجتماعيا لا يعني بالضرورة أن تعتبر مؤنثا. أما فيرجينا وولف فإنها تستحضر كره النساء الثقافي الذي يمكن أن يستثيره الوضع المجازي الملتوي للأنوثة، فهي ترى أن من الصعوبة تمييز مسألتي الجنوسة والجنسانية بمعزل عن بعضهما البعض عندما تكون الأنوثة موضع نقاش. إن النسوية تستمر في الجدل حول ما هو طبيعي وما هو معطى بيولوجيا وما هو متصور ثقافيا، في حين أن التحليل النسوي للأنوثة قد سلط الضوء على الفضائل الأنثوية المفترضة. ومن جهتها ترى جاكلين روز أن التفكير في الأنوثة بوصفها جزءا من الانقسام والقلق الضروريين للذاتية الإنسانية فتنطلق منه باعتباره سؤالا حول الهوية أكثر مما هو جواب عليها، وهي تقدم في كتاباتها وصفا مفصلا وموسعا للتصور الاجتماعي للجنوسة. بعد ذلك يقدم الباحثان قراءة في الطروحات المختلفة حول مفهوم النسوية والأنوثة في القرنين الثامن والتاسع عشر وفيما بين الحربين العالميتين .
القراء والمشاهدون
في الفصل الأخير يتناولان العلاقات الاجتماعية للقراءة التي تمتلك صفة عمومية وتشكل امتدادا للطقوس اليومية وعادات الحياة اللطيفة، كما يتناولان علاقة الجنوسة بالمجال العمومي إذ كان أهم التطورات الناجمة عن انتشار معرفة القراءة والكتابة في القرن السابع عشر ظهور منطقة جديدة من النقاش الحر والمفتوح حول مفهوم المجال العمومي الذي يرى هابرماس أنه كان يتميز بثلاثة خواص مميزة ومتبادلة جعلت النقد العقلاني المستقل حاضرا بصورة يومية وعاديا في حين أصبحت قراءة الروايات لا تنفصل عن الاستهلاك الأوسع للسرديات الثقافية عبر السينما والتلفزيون إذ باتت تحتل هذه الوسائطُ الفضاءَِ الذي كان ينتمي سابقا للفضاء العمومي الأدبي.
الأجناس
أصبحت كلمة (أدب) في العصر الحديث تعني عند كل الأمم التعبير بالكلمات عن كل ما في الحياة و ما في النفس البشرية من خير و شر على السواء, على أن يقود العمل الأدبي (الأصيل) في النهاية إلى الخير دائما مهما كانت نوعية الصور التي يعرضها ذلك العمل الأدبي, و التعبير بالكلمات لابد أن يكون مبنيا على أسس جمالية فنيه يحدد مواصفاتها و معاييرها النقد الصحيح النزيه الذي تختلف موازينه من عصر إلى عصر.
أهم الأجناس الأدبية:
الخطبة – القصة – القصة القصيرة "الأقصوصة" – الرواية – المسرحية – الشعر
المقال
المقال عبارة عن رحلة إقناع قصيرة يأخذنا فيها الكاتب ليقنعنا بقضية ما أو بفكرة ما لنتعايش معه أو نفهم وجهة نظره و نحترمها على أقل تقدير. و هذه الفكرة عادة ما تكون مبنية على معلومات موثقة لدى الكاتب فيبني عليها مقاله و يزود مقالته بالبراهين و الحجج التي تؤكد فكرته و تدعمها و الأدلة التي تضعف الحجج لمن يخالفه في الرأي.
و على الرغم من اختلاف أنواع المقالات بحسب اختلاف أهداف كُتابها إلا أن كاتب المقال في النهاية يريد أن يوصلنا إلى الاقتناع بفكرته أو الإيمان بها. و للمقالة دور كبير في تغيير المجتمعات و خصوصا أيام الأزمات السياسية و الحربية فهي قد تحبط عزيمة جيش بأكمله و قد ترفع من الروح المعنوية لجيش آخر!! و المقالة قد تكون وسيلة لتفتيح عيون المجتمع على مشاكل أو قضايا كان غافلا عنها فتبرزها المقالة و تدعو لحلها و أحيانا يقدم الكاتب الحلول من وجهة نظره.
ارتبط ظهور المقال و شيوعه في العالم العربي بظهور الصحافة رغم أنها كانت موجودة قديما عند العرب في صورة "رسالة" إلا أن المقالة الحديثة تتميز بالقصر.
المقالة تبدأ بفكرة تكون في رأس الكاتب و تظل في ذهنه فترة من الزمن, تنمو فيها و تكبر و تأخذ الشكل السوي. و هي في تلك الفترة من النمو تتغذى من ملاحظات الكاتب و من قراءاته المتعددة النواحي و من خبراته الشخصية.
إذن شخصية الكاتب و وجهة نظره لابد أن تظهر جلية واضحة في المقال.تحتوي المقالة على:
1- معلومة أو معلومات عن قضية أو فكرة ما يتناولها الكاتب من جانب واحد أو أكثر (ليس شرطا أن يتناولها من جميع الجوانب).
2- التشويق و إثارة القاريء سواء بالأسئلة أو بالسخرية أو بالصور الجمالية أو التشبيهات الجديدة أو التي تلامس الواقع, أو باستخدام ألفاظ لغوية سلسلة و تمس الفكر و الإحساس.
3- براهين أو أدلة تثبت وجهة نظر الكاتب أو تعزز ما يقوله.
أنواع المقالات:
أدبية – سياسية – اجتماعية – نقدية – دينية
الخاطرة
الخاطرة من الأنواع النثرية الحديثة التي نشأت في حجر الصحافة و لكنها تختلف عن المقال من عدة وجوه:
الخاطرة ليست فكرة ناضجة وليدة زمن بعيد و لكنها فكرة عارضة طارئة.
و هي ليست فكرة تُعرَض من وجوه عديدة, بل هي مجرد لمحة.
و ليست مثل المقالة مجالا للأخذ و الرد و هي لا تحتاج لأسانيد و براهين و حجج قوية لإثبات صدقها, بل هي أقرب للطابع الذاتي الغنائي.
و الخاطرة بطبيعة الحال أقصر من المقالة.
الخاطرة عبارة عن تنفيس و تفريغ لما يجول في عقل الكاتب من أفكار و ما يعتمل في قلبه من مشاعر.
الخاطرة فيها قدر كبير من العمق و التركيز و الغوص في النفس البشرية و أحاسيسها و همومها و أفراحها و طرائفها.
ما يميز الخاطرة الناجحة عن غيرها هو أن كاتب الخاطرة لديه أسلوب جذاب بحيث يجعلنا نعيش معه أدق مشاعره و نتفاعل معها و نحس به, و كلما لمس الكاتب واقعا في قلوبنا , كلما نجح في مهمته.
يمكن أن نستخلص من أهم تلك الدراسات والاجتهادات نتائج نراها أكثر فائدة وانسجاما مع ما نحن بصدده، من تلك النتائج أن نظرية الأجناس الأدبية تنحصر في بحث قضيتين أساسيتين هما:
1 - الأسباب الداعية إلى وجود الأجناس الأدبية. 2 - أسس تقسيم الأدب إلى أجناس مع ما يستتبع ذلك من دراسة خصائص كل جنس ومكوناته وما يكتنفه من تطور أو تغير، وبيان أهدافه.
ـ فيما يتعلق بالقضية الأولى: هناك تساؤلات تعددت الإجابات عنها وهي:
هل الأدب -أصلا- وليد الواقع الذي يعكسه الإنسان ويعبر عنه؟ أم أن الأدب دلالة على موقف الإنسان وانعكاس لذاته تجاه الواقع؟
أم أن هناك ارتباطا جدليا بين كيان الإنسان الداخلي، وبين واقعه الخارجي؟ -وهذا أقرب إلى الصحة- ثم إن الأمر لا يقف عند حدود الذاتية الفردية، بل يتجاوزها إلى ما لها علاقة به من أفراد وجماعا! ت، وطبيعة، وما وراء الطبيعة، لتوضيح ذلك بكيفية تفصيلية نرى أن الإنسان مرتبط أوثق ما يكون الارتباط بأربعة أبعاد في حياته:
1 - ذاته الفردية وكيانه الخاص. 2 - جماعته الخاصة والعامة التي تتسع حتى تشمل الإنسانية عامة، بعد عشيرته ومجتمعه الوطني والقومي. 3 - الطبيعة بكل ما تضمه من أحياء ومظاهر وخفايا وعناصر، لأن الطبيعة مكون جوهري لحياة الإنسان. 4 - ما وراء الطبيعة، إذ يتجاوز الإنسان المحسوس إلى ما فوق مدركاته المباشرة، وهو مدفوع أن ينظر إلى عوالم أخرى بحكم عواطفه وخياله وعقله، وما أتت به الأديان من عقائد وعبادات وتشريعات وتوجيهات سلوكية، خاصة الإسلام الذي هو آخر دين سماوي.
إذا نظرنا بإمعان إلى هذه الأبعاد الأربعة التي تحكم حياة الإنسان، ولو بدت منفصلة، فإننا نجد بينها في العمق، ترابطا وتداخلا، وهناك بعد خامس، قسيم للأبعاد الأربعة، يتجلى فيما فطر عليه الإنسان من تطلع مثالي يحدو به إلى توخي الأفضل ونشدان الأرقى في كل ما ينجزه.
إذا حاولنا أن نطبق ما سبق على أسباب وجود الأجناس الأدبية، وما قد يعتريها من تغير وتطور، وظهور بعض الأجناس واختفاء أخرى سنجد ما يأتي:
1 - كل ما يتعلق بذات المبدع، نشأت عنه الأجناس الأدبية التي يعبر بها عن تجاربه الخاصة وهمومه وأفراحه، وخبراته ومواقفه وتأملاته واختياراته، من هذه الأجناس: الشعر الغنائي بكل موضوعاته وأبوابه، ومنها الأجناس النثرية كالأخبار الشخصية والخطابة والوصايا والرحلة، والمقالة الذاتية، والسيرة الذاتية والخاطرة، وهذه الأجناس تتسم بالطابع الذاتي وهو العنصر البارز فيها ويتيح لها أن تنتمي إلى هذا النطاق.
2 - كل ما يهم الواقع الاجتماعي بكل نواحيه المختلفة مما هو خارج عن التجارب الشخصية للمبدع، ويهم الآخرين في تعاملهم وسلوكهم وتصرفاتهم، وكل ما يقع بينهم من صراع وتصالح وتوافق، بمعنى آخر كل ما يتعلق بالحياة العامة الجماعية في نطاق محلي ووطني وقومي أو إنساني، نشأت عن كل ذلك أجناس أدبية، منها الملحمة والمسرحية والقصة والرواية والمقالة الموضوعية والسيرة الغيرية وكل الأجناس التي يعبر بها المبدع عن الآخرين.
3 - نظرا لمكانة الطبيعة في حياة الإنسان فقد نشأ عن ذلك أدب الطبيعة بأصنافه، وهو يضاف إلى الجانب الذاتي أو يحسب على الجانب المحايد الذي نشأت عنه النظرة العلمية، والغالب أن يتماهى أدب الطبيعة مع أجناس ! أدبية خاصة دون غيرها مثل الرحلة، وهي رهينة بالسفر وما يتخلله من حركة وسكون وإقامة وظعن، فالرحلة على هذا الوجه مرتبطة بالمكان على اختلاف المواقع والمشاهد، وكذلك بالزمن، وتتجلى الطبيعة في الفضاء الروائي، وفي مقالة وصف الطبيعة أو في شعر الطبيعة.
4 - بما أن الإنسان مادة وروح، مزود بالقدرة على استشراق عوالم الغيب، بما أودع الله فيه من طاقات تمكنه من الخيال، وتتحكم فيه عواطفه وميوله، كما له طاقات فكرية، لم يترك مع ذلك لأهوائه أو لقدرته الإدراكية العقلية والحسية، التي مهما بلغت، فهي محدودة، رأفة من خالقه به أرسل إليه الرسل وأنزل وحيه من أجل إسعاده في دنياه وأخراه، وفي هذا النطاق نشأت أجناس أدبية كالابتهال والمواعظ وأدب الزهد وأجناس الأدب الصوفي وأدب الحياة الأخرى. وقد تمتزج هذه الأجناس بغيرها، إذ أن حياة المؤمن عامة لا تنفصل عن الجانب الغيبي سواء تعلق الأمر بأجناس الأدب الذاتي أو الغيري. وقد تسخر أجناس أدبية لخدمة العقيدة والشريعة الإلهية بمقاصدها النبيلة الدنيوية والأخروية. إننا حين نمعن النظر فيما تقدم عن حياة الإنسان نجدها وحدة لا تنفصل في العمق، وإن بدت منفصلة في الظاهر. فالحي! اة الفردية مرتبطة بالحياة الجماعية والفرد والجماعة مرتبطان بالطبيعة وبما وراء الطبيعة والحياة الدنيا لا تنفصل عن الحياة الأخرى.
يضاف إلى ما سبق أن حياة الإنسان الدنيوية محكومة بالزمن الماضي والحاضر والمستقبل، أما حياته الأخرى فهي أبدية. والأجناس الأدبية محكومة بهذا المقياس الزمني والمكاني أيضا. فهي إما أن تتحدث عن ماض أو حاضر أو مستقبل أو تمزج بين هذه الأزمنة غالبا.
أما البعد الخامس المشار إليه فيما تقدم والمتجلي في رغبة المبدع في بلوغ الكمال وتحقيق المثال، فهي التي تدفعه إلى بذل كل جهد لديه لتحسين أي إنجاز ينجزه. إن تطلعه إلى أن يكون عمله في أعلى درجات الإتقان والإجادة، ظاهرة ملازمة واضحة عبر العصور، إذ أن إنجازات الإنسان لم تكن أول الأمر إلا بدائية وساذجة ثم سارت في سلم الرقي استجابة لنزوع مثالي في أعماقه. إلا أن ذلك محكوم بمتطلبات كل عصر ومثله وقيمه الجمالية والفكرية والدينية، فالإبداع في مجال العمارة مثلا وصل إلى درجة عالية من الضخامة والفخامة في فترات، وفن النحت حقق الذروة كذلك لدى اليونان والرومان، وفن الملاحم بلغ مكانة مرموقة لدى هومروس وكذلك الرسم حقق أروع مثال ف! ي عصر النهضة وما بعده، وهكذا..
إن كل إنجاز فني يبدأ ساذجا ثم يتولاه الإنسان عبر عصور بالصقل والإجادة وضروب التحسين، ثم قد تطرأ عوامل تدعو إلى اختفائه أو دمجه في فنون أخرى، وهكذا نجد أن الإنسان عبر مسيرته الحضارية قد تنبه، سواء تعلق الأمر بأجناس الأدب المختلفة أو بغيرها، إلى أن وسيلته لتحسين إبداعه هو فحص ما أنجزه ليقف على مكامن الإجادة أو القوة أو مماثلة غيره، وكذلك ليعرف مواطن الضعف والتقصير والنقص. فتولد عن كل ذلك ما صار يعرف بالنقد الأدبي أو الفني كما تولد عنه تاريخ الأدب وتسجيل حياة أعلامه وكل ما يتعلق بدراسة الأدب سواء تعلق الأمر بقضاياه أو اتجاهاته ومذاهبه وخصائصه الفنية.
لحصر هذه القضية إجمالا يبدو أن هناك ثلاثة عوامل فعالة في ظهور واختفاء وتغيير الأجناس الأدبية:
1. تطلبات كل عصر وقضاياه المختلفة
. 2 التقاليد الفنية الموروثة والمستجدة. 3-القدرات الإبداعية للمنشئين وما لهم من عبقرية ومدى استيعابهم للموروث وما لهم من تطلعات.
الأدب
المذهب الأدبيّ أو المدرسة الأدبيّة جملةٌ من الخصائص والمبادئ الأخلاقية والجمالية والفكريّة تشكّل في مجموعها المتناسق، لدى شعب من الشعوب، أو لدى مجموعةٍ من الشعوب في فترة معيّنة من الزمان، تيّاراً يصبغ النتاج الأدبيّ والفنيّ بصبغة غالبة تميّز ذلك النتاج عما قبله وما بعده في سياق التطوّر. ويشمل المذهبُ كلّ أنواع الإبداع الفنيّ كالأدب والموسيقا والرسم والنحت والزخرفة والأزياء والطرز المعماريّة فهو حصيلة فلسفيّة تبلور نظرة الأمة إلى العالم والإنسان، وموقفها وهدفها ومصيرها وبالتالي طرائق تعبيرها الفنيّة.
لا يجري الإنتاج الأدبي والفنيّ بمعزلٍ عن المجتمع والبيئة، والمبدع محكومٌ، إلى حدٍ بعيد، بمحيطه الذي يعيش فيه، ويكوّن جزءاً منه يبادله التفاعل أخذاً وعطاءً، وتأثّراً وتأثيراً، فهو يتأثر بالطبيعة التي تحيط به وتفعل في تكوين صوره ورؤاه ونشاطه وتختلف معطيات الطبيعة باختلافها وتنوعها: فهناك البحار الصاخبة والجبال الجبارة والغابات الغامضة والأنهار المتدفقة والسماء الغائمة الراعدة والرياح المزمجرة.. وهناك الصحارى الساكنة والرمال الممتدّة تحت لهيب الشمس الساطعة والسماء الصافية والليالي الساجية ذات النجوم البراقة.. وإنّ هذه البيئات تختلف حتى في الألوان والظلال والأحاسيس والروائح. ويستدعي اختلافها اختلافاً ضرورياً في الواقع البشريّ من حيث التكوين الجسديّ والطباع وضروب المعيشة والنواحي الذوقيّة والرؤى الفكرية والفنيّة، واللغة وضروب التعبير. وإنّ انتقال الإنسان من بيئةٍ إلى أخرى لا يمحو آثار الأولى بل يجعلها في حوار جديد مع معطيات الثانية تتكون منه رؤى وانعكاسات جديدة متميزة.
ولا يقف الأمر عند تأثيرات الطبيعة، فهنالك ما هو أكثر أهميّة، هنالك البيئة البشرية بكل ما تعنيه من السكون أو الاصطخاب، والتجانس أو التشعّب، والتنوع والتقلّب.. ولا يستطيع المبدع، وهو خليّة من المجتمع، أن يتملّص من آثاره أو يجمُدَ عند تغيُّره. إن البيئة البشرية تعني الثقافة والحضارة وطرق المعيشة والمسكن والملبس والحالة الطبقية والإنتاج الاقتصادي والتقاليد والعادات والأذواق والعلوم والفنون والعمران والحياة الفكرية والشرائع والأشكال السياسيّة. والتمازج بين الشعوب وتلاقح الحضارات والانتصارات والهزائم والاستقرار أو الاضطراب.. وما إلى ذلك من الظروف الاجتماعية ذات التأثير الأكيد على الإنسان عموماً والمبدعين ونتاجهم خصوصاً. وبالمقابل تخضع هذه البيئة لتأثير المبدعين فيها، فالتفاعل بينهما متبادل بل يُعَدّ العاملُ الفكريّ والفنّي من أبرز أسباب التغيير الاجتماعي.
ومن هنا انطلق المذهب التاريخي النقدي الذي عُني بدراسة البيئة ومدى تأثيرها في الآداب والفنون وتأثرها بها ودلالة هذه الإبداعات على ملامح البيئة وتصويرها لتياراتها الخفيّة والظاهرة وإرهاصاتها المستقبليّة. يقول طه حسين في دراسته الأولى للمعري "إن الرّجل وماله من آثار وأطوار نتيجةٌ لازمة وثمرة ناضجة لطائفةٍ من العلل اشتركتْ في تأليف مزاجه وتصوير نفسه.. والخطأ كلّ الخطأ أن ننظر إلى الإنسان نظرتنا إلى الشيء المستقل عما قبله وبعده، الذي لا يتصل بشيء مما حوله، ولا يتأثر بشيءٍ مما سبقه أو أحاط به".
وهذا لا يعني أن المبدعين يتماثلون في طبيعة موقفهم من البيئة تأثيراً وتأثراً، بل يعني طابعاً عاماً يشملهم، فيطبع معظم نتاجهم ونتاج معظهم بصبغةٍ معيّنة هي صبغة العصر، مع احتفاظ كل منهم بخصوصيته وفرادته. ومن هذا التأثير البيئي العام يتكوّن بشكل عفوي، على صعيدي الممارسة والإنتاج "مذهب" لا تتضح معالمه أول الأمر ولا تلحظ قواعده، بل يحتاج إلى مرور عشرات السنين حتى يأتي الدارسون والنقاد والمنظرون الذين يتأملون تلك الظاهرة وأسبابها وتجلياتها وتطورها ثم يخلصون إلى استخلاص قواعدها وفلسفتها وتحديد معالمها وأعلامها ومصطلحاتها وظروفها المكانية والزمانية، وتأثيرها وتأثرها.. فإذا بمدرسة نقدية كاملة تنشأ حول هذا المذهب أو ذاك..
إنّ "المذهب" تكوّنٌ جماعيّ لا يقتصر على فردٍ واحد بل يشمل عدداً كبيراً من المبدعين جمعت بينهم ذوقيّة واحدة وأمزجة متشابهة لوقوعهم تحت تأثير مناخ بيئي عامٍ.. ولهذا دُعيت الرومانسية "مرض العصر" تشبيهاً لها بالجائحة.
والمذهب لا يأتي فجأة فينسخ ما قبله، ولا يزول فجأة أمام موجة مذهبية جديدة، بل يتكون تدريجياً حيث تتعايش آثار المدرسة السابقة والمدرسة الراهنة، ثم تزول الآثار القديمة رويداً رويداً كما يضمحل ضوء النهار أمام زحف الليل، ثم لا يلبث المذهب أن يتلاشى تدريجياً أمام مدرسة لاحقة. وتتزامن آثار المدرستين لدى كاتب بعينه، في بعض الأحيان، أو لدى عددٍ من الكتاب والمبدعين في فترة واحدة. وقد يكون للمذهب بعد انطوائه عودة بملامح جديدة - بل قد توجد في وقت واحد ملامحُ لمدارسَ عديدة، كما هو الأمر في الأدب العربي الحديث حيث تشاهدُ معاً اتجاهات المدارس التقليدية والإبداعية والرمزية والواقعية. والسبب في ذلك اختلاف الشروط الخاصة التي يخضع لها كلٌ من الأدباء والمبدعين كتنوع الظروف والثقافات والأيديولوجيات والمستوى الحضاري والتفاعل مع التيارات الجديدة أو الغربية، وسرعة تطوّر الأديب أو تباطؤه في الاستجابة والتلاؤم واختلاف المواهب والمزايا الفردية. وأخيراً إنها سُنة التطور الطبيعي التي تنافي المفاجأة والطفرة، وتخضع لقانون الفعل وردّ الفعل.
مسألة التجنيس
1ـ ما هو شكل وجود الأجناس؟ هل يتعلق الأمر بتغيرات بسيطة عشوائية أم بماهيات حقيقية؟ "..... ربما لا تكون الأجناس سوى كلمات، وتصنيفات عشوائية، يخترعها النقد من أجل عزائه الخاص فقط، ومن اجل أن يجد نفسه ويعرفها ضمن هذا الكم من الأعمال التي ترهقه عبر تنوعها المطلق ، أو على العكس، هل توجد الأجناس حقيقة في الطبيعة وفي التاريخ؟ هل هي مشروطة من ذاتها؟ أخيراً، هل تعيش حياة خاصة بها ومستقلة ليس فقط عن حاجات النقد، ولكن أيضاً عن أهواء الكتاب أو الغنائيين؟" لا يمكن أن تكون الإجابة عن السؤال الأول إلا إيجابية "لأن النشيد الذي ندمجه بأغنية عند اللزوم ليس مثل كوميديا متميزة مثلاً، والمنظر الطبيعي ليس تمثالاً." في مكان أبعد، سيحدد وسائل كل فن وموضوعاته، وكذلك "العائلات الروحية" (بسبب أن كل عائلة روحية تتعلق بأجناس تناسبها بطريقة خاصة"
2ـ مسألة تكونها وتميزها: "كيف تتحرر الأجناس من الالتباس الأولي؟ كيف يجري فيها التمييز الذي يقسمها أولاً، ثم يميزها بعد ذلك، وأخيراً يفردها."
هذه المسألة والتي يلح عليها برونتيير "شبيهة بصورة ملحوظة مع مسألة كيف يتحرر الأفراد مع أشكالهم الخاصة في التاريخ الطبيعي من وجود أو ماهية عامين ومتجانسين، ويصبحون بذلك الأصل المتتابع للتنوع، والأجناس، والأصناف." ويختم ذلك "ومن مبدأ التطور أخذنا أدلتنا [...]. دون شك ، يتم تمييز الأجناس في التاريخ مثل الأصناف في الطبيعة، بالتدريج، من خلال تحول المفرد إلى مجموع، ومن البسيط إلى المعقد، ومن المتجانس إلى المختلف، بفضل المبدأ الذي نسميه اختلاف الخصائص..
3ـ المسألة الثالثة تتعلق بمشكلة تثبيت الأجناس، أي مشكلة استمرارها التاريخي، وتأمين "وجود فردي لها، يشبه وجودكم أو وجودي، مع بداية ووسط ونهاية"
هذا الوجود هو وجود كائن بيولوجي، وهذا ماقاد برونيتيير إلى تأكيد أن المسائل الأكثر أهمية تتعلق بتحديد شباب الجنس، وضعفه، وأيضاً نضجه بصورة خاصة، أي اللحظة التي يحقق فيها كمال قواه الحيوية، اللحظة التي فيها "يتطابق مع الفكرة الداخلية لتعريفه، من ذاته عندما يصل إلى الشعور بموضوعه، فإنه يصل في الوقت نفسه، إلى كمال وسائله وإتقانها.
هذا يعني أن تعريف الأجناس لايمكن أن يكون إلا جوهرياً: لن نتمكن من فهم تطور جنس معين إلا عبر معرفة "ميزته الأساسية
4ـ مسألة تغيرات الأجناس، أي تحليل القوى التي تسهم في عدم ثبات جنس ما، وانحلاله، وتفككه واحتمال إعادة تشكله. يرى برونيتيير أن هذه المسألة هي الأكثر تعقيداً وعندما ستحل فإنها ستلقي الضوء على وضع الأجناس.
من بين عوامل عدم الاستقرار والتطور التعديلي، يذكر الوراثة أو الأصل، وتأثير الأوساط الجغرافية، والجوية، والاجتماعية والتاريخية، وتأثير الفردانية خاصة. يعد هذا العنصر الأخير أساسياً من وجهة نظر برونيتيير: لاتريد نظرية التطور استبعاد الفرد كقوة غائية في التطور الجنسي، وتعطيه مكاناً مرموقاً: أدخل الفرد في تاريخ الأدب والفن شيئاً لم يكن يوجد فيه قبله، ولن يوجد فيه من دونه، وسيستمر فيه من بعده . لايوجد شيء أكثر ملاءمة لقانون التطور من التأكيد على هذا السبب المحوِّل للأجناس، لأنه في حقيقة القول، سيكون الطبع وفق أصل الأنواع هو بداية كل التغيرات. أو أيضاً "سيكون نقطة انطلاق كل تغير تشكيلي في صنف جديد ظهور خاصية جديدة في الفرد."
يعطي التطور الجنسي الذي نُظر إليه بحسب النظرية الداروينية، دوراً مهماً ليس فقط للاستثناء والحالة العرضية، ولكن أيضاً لإمكانية التغيرات المفاجئة بصورة أكثر عموميةفي الواقع، يدعم برونيتيير فرضية تثبيت التبدلات المفاجئة ضد المدافعين عن تكديس التغيرات البطيئة، تتطابق الأولى بصورة أفضل مع المكانة المهمة التي يعطيها للأعمال القانونية في التاريخ الأدبي.
5ـ مسألة تحول الأجناس، وهذه قد تؤدي إلى الوقوع في الخطأ، لأن برونيتيير، في الواقع، يريد من خلال هذه المسألة معرفة فيما إذا كان يوجد قانون عام يتحكم بعلاقات الأجناس بين بعضها، فيما وراء القوانين التي تتحكم بالتطور الداخلي لكل جنس. إنه يظن أن مثل هذا القانون موجود ويتطابق مع القانون الأساسي للتطور الأدبي،
أي قانون الانتقاء الطبيعي، "التنافس الطبيعي"، و "استمرار الأكثر قوة" : "..إذا كان ظهور بعض الأصناف، في زمان ومكان معينين، يسبب زوال بعضها الآخر، أو أيضاً، إذا كان صحيحاً أن الصراع من أجل البقاء ليس شرساً دائماً إلا بين الأصناف المتجاورة، ألا نعثر على كثير من الأمثلة التي تذكرنا بأن الأمر لم يكن بعيداً عن ذلك في تاريخ الأدب والفن؟" . هذه النظرية هي التي ستقود كل التحليلات التاريخية، وخاصة تحليلات كتابه "فهرس تاريخ الأدب الفرنسي": يجب أن يفرد التأريخ مكاناً لعلم الأنساب، أي لتاريخ الولادة التدريجية للأجناس عبر صراعها المتبادل. الأمر نفسه بالنسبة للمنهج التطوري الذي يكتفي بتصنيف إحصائي بسيط للأجناس. من المؤكد أن برونيتيير يمجد التصنيف : "الغاية الطبيعية لكل علم في العالم هو التصنيف، ضمن نظام شبيه بنظام الطبيعة، للموضوعات التي تشكل مواد أبحاثه." ولكنه يضيف مباشرة أن هذا التصنيف لن يكون آلياً (مثل تصنيف linnل ) : التصنيف الجنسي الإحصائي أو الآلي فقط لن يكون إلا تصنيفاً مصطنعاً أو عشوائياً، حيث لن يُسقط إلا الأجناس، التي هي أعضاء حية، ولا تتواجد إلا في الزمن وبصورة أكثر خصوصية، في الصراع الحيوي التي يكون فيه الزمن هو حقل المعركة. ما يلزم إذن هو علم أنساب الأجناس، "إذا لم تتعرّف الأجناس، مثل العناصر في الطبيعة، إلا عبر الصراع الذي يجري فيما بينها في كل زمان، فما هو التراجي ـ كوميديا مثلاً غير انتقال الدراما بين الرواية والتراجيديا؟ وكيف نراها إذا فصلنا دراسة الرواية عن دراسة التراجيدية.
تثوّر النظرية التطورية إذن مناهج التاريخ الأدبي: " من وجهة نظر وصفية، وتحليلية، أو إذا تجرأت على القول ببساطة، إحصائية وحسابية، إنها تحل محل ما ندعوه وجهة نظر علم الأنساب.
------نظرية التجنيس في الأدب -------
يوجد تتابع في الأعمال في الأدب كما في الفن، عبر كل الأزمنة إن ما يفرض ثقله أكثر على الحاضر هو الماضي. كما في الطبيعة، إننا نعتقد أن الشبيه يولد دائماً الشبيه وهذا غلط، والتطور يتابع طريقه، في حين أننا لا نعتقد أيضاً بمحاكاة أو إعادة استحضار الماضي، وهناك حركة خرساء تجري في أعماق الحياة، لا نرى منها شيئاً يظهر على السطح، ولكنها ستدهشنا في يوم من الأيام عندما نع
رف أنه في ظرف عدة سنوات قد جددت كل شيء، وحولت كل شيء، ونقلت كل شيء من الشبيه إلى النقيض. إن محاولة الإمساك بهذه الحركة وتحديد طبيعتها، واتجاهها وقوتها وخاصيتها هذا هو الموضوع الذي يقترحه المنهج التطوري، ويمتد إلى الأدب بالأساليب نفسها الموجودة في التاريخ الطبيعي."
عندما نقارن هذا المشروع بمشروع هيغل، يظهر لنا مباشرة اختلافان مهمان. فمن جهة، يرفض برونيتيير، بعكس مؤلف "علم الجمال"، أن يرى الأدب كتعبير عن حقيقة أخرى غير حقيقته. هذا يظهر عبر جداله مع تين الذي يضع نفسه في صف هيغل في هذا المجال.
أولاً، إنه يعبر عن شكوكه بفرضية التطابق الضروري بين كل النشاطات الروحية لعصر معين ،أي الوحدة المنهجية التي، من وجهة نظر تين، تربط كل الفعاليات لروح أو لجنس بعينهما. يرى برونيتيير أن تين يعطي أهمية كبيرة للأصل، أهمية اللحظة، أي التطور، أكبر من أهمية الأصل.
ومن هنا تأتي المكانة المركزية التي يحتلها عنده تقسيم الأدب وفق العصور الأدبية، وفرضيته التي تقول إن الوجود البيولوجي للأشكال الفنية هو في الوقت نفسه وجودها التاريخي. يعلن هذا المبدأ العام عند حديثه عن الرسم الهولندي: "تطوره، هو تاريخه، وليس له من تاريخ غير تاريخ تطوره."
ولكن ما يأخذ على تين هو عدم اعتباره العمل الفني إلا كدلالة عن حقيقة أخرى يجد فيها غايته. والحالة هذه "إن العمل الفني هو عمل فني قبل أن يكون دلالة؛ [...]، وهو يوجد بذاته ولذاته." إذا لم ينف تأثير العوامل الخارجية في الأدب، فإنه يؤكد مع ذلك بقوة أن التأثير الأساسي الذي طوره "هو تأثير الأعمال في الأعمال": "بعد تأثير الفرد، إن التأثير الكبير الذي يجري في الأدب والفن، هو تأثير الأعمال في الأعمال. أو نريد أن نزاحم في جنسهم أولئك الذين سبقونا: هكذا تتسارع الأحداث، وتتشكل المدارس، وتفرض التقاليد نفسها أو ندعي فعل شيء غير الذي فعلوه، ويناقض التطور التقليد، وتتجدد المدارس، وتتغير التصرفات" ولكن يجب أن نرى جيداً أنه بالنسبة لبرونيتيير إن تأثير الأعمال في الأعمال ليس، في الواقع، إلا تعبيراً عن قانون خفي هو قانون جيل الأجناس. العلاقة التي يفكر فيها ليست إذن علاقة تناصية جمعية، إي علاقة واضحة وواعية تتوطد بين أعمال مؤلفين مختلفين في عصور مختلفة، ولكنها علاقة وراثة داخلية لعلم الأنساب الجنسي: "في كل لحظة من التاريخ، كل من يكتب في الفن أو الأدب [...] فإنه يكتب تحت ضغط كل أولئك الذين سبقوه سواء عرفهم أم لم يعرفهم ." ترتبط العلاقات بين الأعمال الأدبية إذن بدقة بحدود العلاقات بين الكائنات في الفصيلة البيولوجية الواحدة. هذا المنطق الوراثي الداخلي هو الذي يؤسس استقلال المجال الأدبي.
النقطة الثانية التي تميز بها برونيتيير عن هيغل تتعلق بوضع الصيرورة التاريخية للأدب: لا يخضع تطور الأجناس لغائية عامة، وخاصة لمبدأ التطور. من وجهة نظر داروين، لا يوجد غائية داخلية للتطور البيولوجي، وكل شيء يفسر من خلال استمرار التجديدات الوراثية الأكثر تلاؤماً، وفق ظروف المكان ومزاحمة الأصناف الأخرى، لذلك فإن تطور الأدب يتفسر من خلال استمرار التجديدات الأدبية الأكثر تلاؤماً، ومن خلال زوال الأشكال غير الملائمة، ومن خلال الصراع بين الأشكال المتجاورة...الخ. هكذا يعرف الأدب ليس فقط مراحل تطور، ولكن أيضاً مراحل تراجع وتقهقر، ويرفض برونيتيير قبول وجود "أي قانون ثابت للتطور." بالتأكيد، يوجد قانون للتطور الأدبي، ولكن هذا القانون يتلخص بالمبدأ الذي تحدثنا عنه سابقاً، اختلاف الخصائص، أي "بحسب رأي هيربر سبنسر، الانتقال من التجانس إلى الاختلاف، أو أيضاً، كما يقول هاكيل، [...] فكرة الاختلاف التدريجي للمادة الأولية البسيطة."
هكذا، إن قانون التطور الأدبي هو قانون التميز التدريجي الذي يتطلب الانتقال من التجانس إلى الاختلاف، ومن الشبيه إلى نقيضه، ضمن تتابع حتمي للأصناف الأدبية التي تتنافس فيما بينها. في المقابل، كما سنرى، في مستوى التطور الداخلي للأجناس، يتابع برونيتيير الدفاع عن طروحات غائية في نهاية المطاف. أول ما يدهشنا عندما ننظر في نظرية برونيتيير هو فرضية أن الأجناس الأدبية أصناف بيولوجية تمتلك صفة وتعريف خاصين، وهذه الفرضية غامضة بصورة كاملة، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار للتفسيرات الأخرى التي يعطيها للتطور الأدبي. عندما يدافع عن رأيه في أن العامل الأساسي في التطور الأدبي هو تأثير الأعمال في الأعمال، وأن تنوع الأعمال الأدبية مثل محاكاتها يتفسر من خلال أن الكتاب إما أنهم يريدون تقليد سابقيهم أو أن يخالفوهم، فإنه يمتلك عاملين يمكن أن يكفيا بصورة كاملة لتفسير التطور الأدبي. منذ هذا الوقت، لم نرَ ما قدمته الفرضية التي تعد الأجناس كائنات بيولوجية ومجردة في الوقت نفسه. هناك أكثر من ذلك: إذا كانت هذه الفرضية غير قادرة على تفسير الصراع بين الكائنات (الكتاب)، فإن الأجناس المتصورة بهذا الشكل، لا يمكن أن تُفسر إلا انطلاقاً من هذا الصراع. لذلك فإن المبدأ التفسيري المزعوم (صراع الأجناس) هو، في الواقع، الظاهرة التي يتوجب تفسيرها. بالإضافة إلى ذلك، لا نرى بوضوح لماذا يجب أن يكون الصراع بين مؤلفين يكتبان أجناساً مختلفة، أكثر حدة من حيث المبدأ، من الصراع بين مؤلفين يكتبان الجنس نفسه: سيكون معقولاً مساندة الفرضية المقابلة. في النهاية نضيف أن فرضية الصراع الدائم بين الأجناس أقل وضوحاً مما يظهر، لاسيما أن برونيتيير يشرح ميزتها، من خلال تنوع موضوعاتها ("لن نذهب إلى المسرح للهدف نفسه وهو الوعظ")(54): ضمن هذا الإطار، لماذا نرى لدى بعض النشاطات التي لها أغراض مختلفة، اتجاهاً طبيعياً للقيام بصراع عنيف؟ في الواقع، المقدمة النظرية الجوهرية لبرونيتيير التي تفسر تطور الأدب من خلال الصراع الحيوي بين الأجناس (مهما يكن المعنى الذي نعطيه لهذا التعبير، أي إذا اعتبرناه، بعكس برونيتيير، اسماً عاماً بسيطاً يشمل طبقة من النصوص)، هي بالتأكيد مقدمة خاطئة، على الأقل كفرضية عامة. وتبدو جزئياً معقولة، عندما تكون قادرة على تفسير العلاقات الموجودة بين أجناس قريبة من بعضها. ويختتم كلامه منطلقاً مما يدعوه انحطاط الشعر الغنائي في النصف الأول من القرن السابع عشر: "إن تحول الشعر الغنائي وانحطاطه في السنوات الأولى من القرن السابع عشر، هو الثمن الذي دفعه لنا تطور الشعر الدراماتيكي وفن الخطابة وانتصارها.[..]. مثلما أنه في الطبيعة لا يمكن لصنفين متقاربين النمو والازدهار معاً في منطقة واحدة، ولكن ما يستطيع أحدهما كسبه في معركة الحياة، يجب أن يخسره الآخر، لذلك لم نرَ مطلقاً، في أي زمن من تاريخ أدب معين، أنه كان هناك مكان لكل الأجناس في وقت واحد، ولكن إذا وصل أحدهما إلى الكمال، فإن ذلك يكون على حساب جنس آخر دائماً."
ولكن في مناسبات عديدة، يعمم برونيتيير فرضيته مؤكداً، كما رأينا، أن "الأجناس لا تعرف بنفسها، كالكائنات في الطبيعة، إلا من خلال الصراع الذي تقوم به ضد بعضها بعضاً."
فُرض هذا التعميم عليه من خلال النموذج الدارويني، لأنه وفق نظرية التطور لا يوجد الصراع الحيوي فقط بين الكائنات المتقاربة، ولكن أيضاً بين الكائنات البعيدة عن بعضها تطورياً. دون شك، ألا يتعلق الأمر بنفي وجود صراع بين مؤلفين، في بعض العصور وفي بعض الظروف الخاصة، يهدف إلى تغليب الأشكال الأدبية التي يمارسونها ضد الأشكال المتقاربة: هكذا أراد غوته ولينز ومسرحيون آخرون فرض نموذجهم لدراما "محايدة" ضد الدراما الكلاسيكية. صحيح أن الكلاسيكية الفرنسية اعترضها، من جملة ما اعترضها، مسألة سيادة الشعر الملحمي أو الشعر الدراماتيكي: ألا يجب أيضاً مطابقة السيادة الطبقية مع الصراع من أجل البقاء بصورة آلية. على كل حال، يمكننا جمع مثل ذلك أو أكثر من الأمثلة التي تظهر، بالعكس، "تعايشاً سلمياً" بين الأجناس المختلفة جداً وحتى بين الأجناس القريبة من بعضها بعضاً: الرواية الجاسوسية، والرواية البوليسية قريتبان من بعضهما، بالتأكيد، وهذا لم يمنعهما من التعايش سلمياً منذ عدة عقود. من المؤكد إذن أن الأمر لا يتعلق بقانون عام. بالإضافة إلى ذلك، وإن وجد مثل هذا الصراع العام، فإن القائمين بهذا الصراع لن تكون، بالتأكيد، "الأجناس"، بل الأفراد الذين يبدعون الأعمال. يمكن إضافة اعتراض ذي طبيعة منطقية إلى هذه الاعتراضات المنهجية والتجريبية: حتى ولو قبلنا أن للأجناس الأدبية وجوداً غير وجود المصطلحات التصنيفية البسيطة فإنه لا يضر القول أخيراً إنها تخدم كالكائنات الطبيعية.
في الواقع لا ُيظهر برونيتيير في أي مكان أنه لا يوجد إلا نموذجان لإمكانية الوجود بالنسبة للأجناس: إما أن تكون مصطلحات تصنيفية عشوائية أو أن تكون كائنات بيولوجية، وكذلك لا يُظهر في أي مكان أن تشابه النصوص لا يفسر إلا من خلال وجود أصناف بيولوجية تكون النصوص تعبيراً عنها. في هذا المجال، إذا كان هناك احتمالات أخرى غير الاحتمالين اللذين قدمها برونتيير فإن رفض الفكرة الأولى لا يبرر بصورة آلية قبول الفكرة الثانية. الاعتراض الممكن هو الذي يميل إلى اعتبار مسألة التصنيف المنطقي للفرضية البيولوجية عديمة الفائدة، ومن المهم فقط معرفة ما إذا كانت هذه الفرضية مفيدة في تفسير الظواهر الأدبية، ويمكن أن تستبعد هنا: رأينا أن هذه الفرضية حشو، بعيداً عن تفسير الظواهر الأدبية التي يحللها برونيتيير. ولكن ألا يمكن أن يكون لها، على الأقل، قيمة استكشافية؟ مما لاشك فيه أن لبعض نتائجها مثل هذه القيمة، مثلاً النقاش الخاص بتعاقب التبدلات البطيئة والتبدلات المفاجئة، وفرضية التحول التدريجي للأشكال الأدبية، وكذلك فرضية وجود طبقة من الأجناس في بعض العصور. ولكن قيمتها الاستكشافية تصبح مسبقاً عديمة الفائدة عندما ننتقل إلى فرضية التطور التاريخي للأجناس، أو فرضية الصراع العام، بين مؤلفين يكتبون أجناساً مختلفة. عن طريق فرض النموذج البيولوجي كشبيه للتطور الداخلي للأجناس، مما يتطلب فرضية الولادة، والنضج، والانحطاط لهذه الأجناس نفسها، فإنه يبدو لي أن النظرية الداروينية تؤدي مسبقاً دوراً سلبياً واضحاً، في المعنى الذي تزوّر فيه التحليلات التاريخية. أما فيما يتعلق بالفكرة الرئيسة التي تعطي الأصناف النصية خاصية بيولوجية، وتفترض صراعاً حيوياً بين هذه الأصناف، فإنها ببساطة حمقاء منطقياً. سواء كان الصراع من أجل البقاء هو القانون الطبيعي للكائنات الحية، ويظهر هذا أيضاً بين الفنانين حيث يمكننا أن نجد فيه آثاراً لبعض نماذج تطور الفنون، فإن ذلك يبقى نظرية يمكن أن تكون صحيحة أو مغلوطة. ولكن بدلاً من الكائنات البشرية، كان القائم بهذا الصراع الداروييني هي الأجناس، وكانت الأجناس الأدبية كائنات بيولوجية وليست مختارات من الأعمال، فإن ذلك يرتكز ببساطة على مزج بين الطبقات يجب على تلميذ في الثانوي أن يتجنبه
في وقتنا الحاضر. في نهاية الأمر، إن الدور الأساسي الذي تؤديه نظرية التطور في تشكيل التاريخ الأدبي عند برونيتيير هو دورٌ أخلاقي وجدلي. كما عند هيغل، الخاصية الموضوعية المزعومة للمنهج الذي يسمح بتشكيل التاريخ الأدبي في مجال متجانس، هي في الواقع، في خدمة صياغة قانون أدبي. من المؤكد أنه يشير إلى أنه بفضل نظرية التطور أصبح النقد "علماً شبيهاً بالتاريخ الطبيعي" ، أو أيضاً أن "الفائدة الكبيرة للمنهج التطوري ستكون في المستقبل إبعاد "الذاتية" من التاريخ الأدبي والفن، ولذلك، منح أحكام النقد السلطة التي رفضنا أن نعطيها له حتى الآن" ولكن لهذا العلم الطبيعي للأجناس هيئة مضحكة. ننتظر ما يقود الناقد إلى جمع مايمكن جمعه من الشهادات المتعلقة بوجود هذا الكائن الجنسي أو ذاك، ثم يستخلص منها السمات الثابتة، وحساب الخلافات بالمقارنة مع هذا النموذج المتوسط، ومحاولة تفسيرها، وتحليل كيف تحول العلاقة بين النموذج والخلافات العنصر المقصود، وهكذا إلى آخره. في الواقع، هذا خطأ: الشيء الوحيد الذي يهم برونيتيير هو ما يسميه النموذج الأساسي، بعكس فرضيته التي تقول إن كل عمل هو مجموع كل الأعمال التي سبقته، فإنه لا يأخذ في الاعتبار، عندما يتعلق الأمر بتاريخ مجرد، أن بعض الأعمال تؤثر في القانون الأدبي. ويبرر لنفسه بالإشارة إلى أن المنهج الدارويني يسمح للمؤرخ بأن يفرز، داخل كائنات الجنس الواحد، بين الكائنات المهمة من وجهة نظر تطوره، والتي تعبر إذن عن ماهيتها، وبين الكائنات غير الملائمة بالمعنى الكامل للكلمة. هكذا أدى التاريخ الأدبي المستوحى من داروين إلى علم تحسين النسل الذي ينفذ بوعي: "وهذه فائدة أخرى للعقيدة التطورية: تهمل شوائب التاريخ الأدبي والفني، وتمحيها وتطردها بصورة آلية." يجب عدم الاحتفاظ إلا "بالأعمال ذات الدلالة في كل جنس، والتي أوصلت مراحل هذا الجنس نحو الكمال": مثلاً، بالنسبة للمسرح في القرن السابع عشر، لم يكن هناك حاجة أبداً لأخذ روترو في الحسبان، لأن كل ما لدى هذا المؤلف موجود عند كورنيه وأنه "لو لم يوجد عمله، فلن يؤثر ذلك في تاريخ المسرح؛ ولم تعطه بعض الاستعارات التي أخذها عن كورنيه وموليير وراسين إلا الحق في أن يكون متميزاً تبعاً لهؤلاء الكتاب. وبفضل المنطق التطوري الحتمي نفسه يجب إعطاء الأفضلية "لماليرب" و "بوالو" على سان ـ أمان، أو تيوفيل، الذين، على الرغم من موهبتهم "لم يكونوا إجمالاً إلا متأخرين" و "وهم أنفسهم متخفون في التاريخ أو مبعدون عنه" ولكن النموذج التطوري لا يسمح فقط بإبعاد بعض المؤلفين والأجناس وتهميشهم، بل يسمح أيضاً بتشكيل التاريخ الأدبي في تابع من الحلقات النوعية التي تمتلك كل واحدة منها قمتها الخاصة التي تتطابق، وفق الفرضية الجوهرية، مع الطبقة الداخلية للجنس المقصود. هنا برونيتيير لا يبتكر شيئاً، وكذلك عندما يرفع النظرية البيولوجية إلى نهايتها المطلقة بإعطائه الجنس حياة فردية خالصة بالمعنى القوي للكلمة. الحالة المثالية لمثل هذه الحلقة هي حالة التراجيديا الفرنسية، التي يقول عنها هو نفسه إنها "مثال رائع، إذا لم نقل وحيداً، للشكل الذي يولد فيه جنس معين، ويكبر، ويصل إلى كماله، ويتراجع، وأخيراً يموت. يمكننا أن نلاحظ أن علم الأنساب يتدخل بصورة شاملة في مستوى التطور الداخلي للأجناس، على الرغم من رفضه على مستوى التطور العام للأدب: كل جنس يحاول شيئاً فشيئاً أن يصل إلى نقاء نموذجه، ثم يتراجع حتماً. هذا يعني أنه في مستوى التاريخ الداخلي للأجناس، تحل الجوهرية النسبية الأكثر كلاسيكية محل الفرضية التطورية (كما رأينا عند أرسطو) منذ أن يتعلق الأمر بتجديد النصوص الممثلة لنموذج جنسي، على الرغم من ضرورة الفرضية التطورية لتفسير التطور الزمني. هنا يتناقض برونيتيير بصورة كاملة مع مقدماته الخاصة: ليس للتطور الجنسي الداخلي غاية، في حين أن التطور الجنسي الباطني لا يمكنه كذلك الوصول إلى غاية، لأنه، بفضل النظرية التطورية، تعد آليات التبدل والتطور هي نفسها في الحالتين (في الواقع، بالنسبة للنظرية التطورية لا يوجد هنا ظاهرتان اثنتان، بل ظاهرة واحدة، تعمل بسرعات مختلفة). بقول آخر، عندما يحلل برونيتيير التشكيل الداخلي للأجناس الأدبية، فإنه لم يعد يعتبرها أصنافاً بالمعنى الدارويني لل